What do you think?
Rate this book
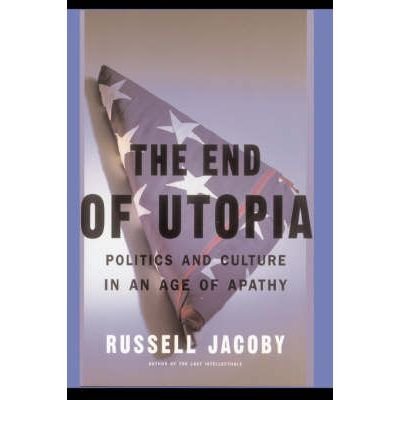
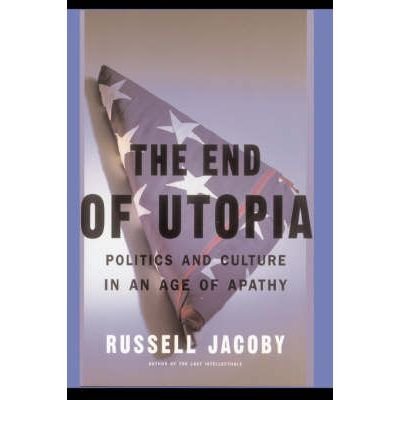
252 pages, Paperback
First published January 1, 1999
"إننا خارج نطاق السيطرة "فاشتداد الكوارث في كل أرجاء العالم
يهدد بأن يغرق الرخاء والحريات المقلقة في الغرب... إن الحقيقة المبتذلة هي أن المستقبل سيكون قاسياً وعنيفاً وغير مؤكد "
هل يمكن لأحد أن ينكر أنه لو عاش في مجتمع يجعله في إحساس دائم بامتياز الآخرين عليه
وبأنه دون قيمة على الإطلاق
فإن من شأن هذا الإحساس على وجه العموم أن يجعله مكتئبا وعاجزا شبه مشلول ؟
"لقد تخلى أساتذة الأدب الجدد عن الحقيقة من أجل الفن
ثم تخلوا عن الفن من أجل فهم الفن
وهم في تمردهم على العملية أبدلوا القيم
...وباسم الهدم أرسلوا الفن إلى ذلك المستودع المسمى بالذاتية وأبقوه حبيسا هناك لزمن طويل"