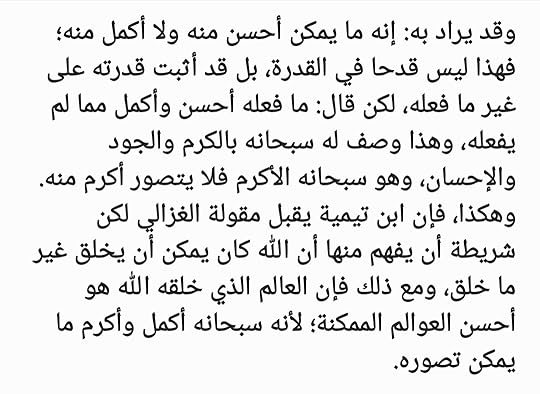What do you think?
Rate this book


400 pages, Hardcover
First published May 28, 2007
الإله هو المعبود، وتعلق الاستعانة بربوبيته، فإن
رب العباد الذي يربيهم، وذلك يتضمن أنه الخالق لكل ما فيهم ومنهم، والإلهية هي العلة الغائية، والربوبية هي الفاعلية، والغائية هي المقصودة؛ وهي علة فاعلية للعلة الفاعلية، ولهذا قدم قوله وإياك نعبده على قوله «وإياك نستعين»، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية؛ فإنه من لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك أنه لم يقر بربوبية غيره.
في فتوى (الإرادة)، يشرح ابن تيمية مسألة حكمة الإرادة الإلهية، وذلك في رده على سؤال متعلق بتعليل الإرادة الإلهية، ويشمل سؤال الفتوى الخيارات الميتافيزيقية (الغيبية) المتاحة بإيجاز، كما يوفر مدخلا مفيدا إلى تصنيف ابن تيمية النموذجي للأقوال المختلفة في هذه المسألة. يقول الشيخ : عن حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأنام وهل يخلق لعلة أو لغير علة؟ فإن قيل لا لعلة فهو عبث -تعالى الله عنه- وإن قيل لعلة فإن قلتم إنها لم تزل لزم أن يكون المعلول لم يزل ، وإن قلتم إنها محدثة لزم أن يكون لها علة، والتسلسل محال.
يبدأ ابن تيمية بايجاز كبير موضحا أن تسلسل حكم الله هو تسلسل في الحوادث المستقبلة لا في الحوادث الماضية، إذ يقول: إذا فعل (الله) فعلاً لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل، فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدها؛ كان تسلسلاً في المستقبل، وتلك الحكمة الحاصلة محبوبه له وسبب لحكمة ثانية، فهو لا يزال سبحانه يُحدِث من الحكم ما يحبه ويجعله سببا لما يحبه.
والقول بإيجاز هو أن الله بكماله لم يزل يريد ويخلق المخلوقات من نوع أو آخر لحكمة ما، بإرادته وقدرته. هكذا تبنى ابن تيمية على الدوام رؤية ديناميكية للذات الإلهية، وتميزه هذه الرؤية عن كثير من -وربما كل- التقليد الإسلامي الكلامي والفلسفي السابق عليه، وخصوصا عن ابن سينا شريكه في النزعة التفاؤلية. يرفض الشيخ قول المتكلمين بأن الخلق له بداية محددة، كما يطرح جانبا قول ابن سينا بالفيض وبالإله المتعالي على الزمان، إلا أنه يتمسك بالقول بوجوب خلق الأصلح؛ والذي ينطوي عليه مفهوم ابن سينا عن الإله. كذلك يصور ابن تيمية خلق الله للعالم باعتباره خلقا اختياريا ديناميكيا، ومع ذلك يرى أن هذا الخلق من اللوازم الضرورية لكمال الله وغناه..
ولكي نلخص تصنيف الخلق والأمر: يتهم ابن تيمية الصوفية والأشاعرة بأنهم يثبتون قدر الله على حساب أمره، وينحرفون إلى مذهب وحدوي يفني الوجود البشري في الله بالكلية، وينتقد المعتزلة لثنويتهم في إنكار خلق الله لأفعال العباد، كما يوبخ الذين يرفضون -بوقاحة- الخلق والأمر الإلهيين باعتبارهما عبثا وظلما. أما ابن تيمية نفسه فيثبت حقيقة مسؤولية الإنسان المتضمنة في الأمر الإلهي والطابع الشمولي للخلق الإلهي، دون تفضيل أحدهما على الآخر. والشيخ هنا لا يبذل جهدا كي يحل معضلة الخلق والأمر بعقلانية، وإنما فقط يتصدى لأوجه النقص الأخلاقية والعقدية التي يلاحظها في حلول الآخرين.
ثم يناقش ابن تيمية كيفية ظهور ألوهية الله وربوبيته في البشر، فآثار الألوهية وأحكام الشرع تظهر فقط في أولئك الذين يعبدون الله ويتخذون منه خليلًا، ويوافقونه فيما يحب ويرضى، ويتبعون أوامره ويجتنبون نواهيه. والله يظهر آثار ربوبيته وأحكام قدرته في كل من المؤمنين والكفار؛ إذ يمن عليهم بالرزق والملك والجمال والعلم والتجارب الدينية. فتجلي الربوبية بشكل منفصل عن الألوهية يتضح بخاصة في فرعون، وفي الغازي المغولي جنكيز خان، والمسيح الدجال. وأما تجلي الألوهية والربوبية معا فيحدث في الملائكة وأنبياء الله وأخلائه كالنبي محمد والمسيح ابن مريم. ويزيد ابن تيمية فيذكر أن الربوبية توافق أحكام «الكلمات الكونية»، والألوهية توافق أحكام «الكلمات الدينية».
وهناك مثال آخر في معارضة ابن تيمية لتفسير ابن عربي للقضاء، ففي الآية التي تقول: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» [الإسراء: ٢٣] يفهم ابن عربي القضاء بمعنى أنه لا يوجد في هذا الكون من يُعبد سوى الله، ولا يهم من قد يكون معبوده المباشر، وفي قصة هارون وموسى والعجل -مثلا- يقول ابن عربي إن موسى علم أن هؤلاء الذين يعبدون العجل هم في الحقيقة يعبدون الله؛ لأن هذا هو ما قضى به الله. ويرى ابن تيمية أن ابن عربي يخطئ إذ يفسر القضاء في هذه الآية (الإسراء: ٢٣) بالمعنى الكوني، بينما سياق الآية يكشف أن القضاء يعني الأمر.
النفس مضطرة في صورة مختارة، وحركاتها تسخيرية أيضا كالحركة الطبيعية فإنها تكون بحسب أغراض) ودواع فهي مسخرة لها. إلا أن الفرق بينها وبين الطبيعة أنها تشعر بأغراضها، والطبيعة لا تشعر بأغراضها
وهناك نسخة كاملة وواضحة من حجة المحدث تسير كما يلي. يذكر ابن تيمية أولا أن الإرادة البشرية أو الفعل البشري يحدث بعد عدم. والآن، كما يحتج، فإن الحادث إما له مُحدث أو ليس له. إن لم يكن له فإننا بالتالي أما إحداث بلا محدث. وإن كان للفعل محدث فلا بد أن يكون العبد أو الله أو غيرهم. إن كان العبد، فإن محدث الفعل نفسه يستلزم محدثا سابقا عليه وهكذا دون انتهاء. وهذا مستحيل؛ لأن تسلسل الحوادث لا يمكن أن يقوم في البشر الذين هم أنفسهم محدثون. وإذا كان المحدث شيء آخر، تظل مشكلة التسلسل قائمة كما لو كان المحدث من البشر.
وخلاصة القول هو أن ابن تيمية يقول بوجود قدرة واحدة هي صحة جسم الإنسان للقيام بالأفعال، والتي هي شرط التكليف الإلهي له. كذلك يقول الشيخ بقدرة ثانية - يشير إليها بالإرادة أو القدرة أو الاستطاعة، أو بالألفاظ الثلاثة بالتبادل- تُحدث فعل الإنسان، وهي القدرة التي يخلقها الله مباشرة.

وفي نصوص أخرى، يقدم ابن تيمية العديد من الأمثلة على خلق الله بالأسباب . فالله قد يخلق ارتفاع الأسعار بسبب ظلم الناس، وانخفاضها بسبب إحسان بعضهم. وقد يرزق الله الناس بأسباب العمل المعتادة لديهم، أو بأسباب غريبة كالجن والملائكة. وقد يجعل الله من الكسوف أو من الريح الصرصر سببا للعقاب من والعذاب، وكذلك الكواكب وهبوب الرياح وضوء الشمس ونور القمر؛ كل ذلك قد يجعل الله منه أسبابا للحوادث في الأرض. والدعاء والشفاعة أيضا الأسباب التي بها ينفذ الله ما يقضيه، كما أن النكاح من الأسباب المعتادة التي وضعها الله لإنجاب البشر. والله قد جعل الأفعال سببا للثواب والعقاب تماما كما جعل السم سببا للمرض، والمرض سببا للموت.
وهم (أهل السنة والجماعة) في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله؛ الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء؛ وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل. فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا: «لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ﴾ [الأنعام: ١٤٨]. فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يعجز عن إنفاذ مراده وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات. ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا؛ إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره، والله سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله، فهو مختار مرید، والله خالقه وخالق اختياره.
وليس في مخلوقات الله ما يؤلم الخلق كلهم دائما دائما؛ بل مخلوقاته إما منعمة لهم أو ولا ما يؤلم جمهورهم لجمهورهم في أغلب الأوقات كالشمس والعافية، فلم يكن في الموجودات التي خلقها الله ما هو شر مطلقا عاما. فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص وفيه وجه آخر هو به خير وحسن وهو أغلب وجهيه
ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل، كقوله تعالى: «فمن يرد الله أن يهديه, يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون [الأنعام: ١٢٥]، وقال تعالى: «فلما زاغوا أزاع الله قلوبهم [الصف: 5]، وقال تعالى: «وأما من بخل وأستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى﴾ [الليل: ۸-۱۰]. وهذا وأمثاله: بذلوا فيه أعمالا عاقبهم بها على فعل محظور وترك مأمور. وتلك الأمور إنما كانت منهم وخلقت فيهم لكونهم لم يفعلوا ما خلقوا له. ولا بد لهم من حركة وإرادة. فلما لم يتحركوا بالحسنات: حُركوا بالسيئات عدلاً من الله. حيث وضع ذلك موضعه في محله القابل له - وهو القلب الذي لا يكون إلا عاملا - فإذا لم يعمل الحسنة استعمل في عمل السيئة. كما قيل: نفسك إن لم تشغلها شغلتك.
وخلاصة القول هنا أن ابن تيمية لا يميل إلى نظرية المعتزلة في العدل الإلهي على أساس الإرادة الحرة، والتي تقول بأن الله يعامل الله العباد بمساواة صارمة؛ إذ يختارون بحريتهم الامتثال لأمر الله وبالتالي تحصيل ما يستحقونه من الجزاء العادل مقابل امتثالهم. كذلك يهاجم الشيخ المعتزلة؛ لأنهم يوجبون على الله التصرف وفقا لمبدأ الجزاء، ولسوء
للتدبير الإلهي بطريقة تجعل الله يبدو سفيها وتبطل استحقاقه للشكر.
و نقد ابن تيمية للرؤية الأشعرية في العدل ينحصر في توبيخهم على إنكارهم كون العدل الإلهي يقتضي شيئا من الحكمة؛ اذ الاله المتقلب المندفع الذي يمكنه أن يقوض قاعدة الجزاء من أساسها بحيث يعاقب المؤمنين على إيمانهم أو يجعل في الأنبياء، ومع ذلك يظل يتصف بالعدل؛ مثل هذا الإله لا يستطيع بحكم طبيعته أن يقيم صلة مع البشر على أساس من الوعد والثقة.