بدر الراشد's Blog
January 19, 2018
فوضى الصناديق
في محاضرته الشهيرة “قصة عقلين” والتي يتحدث فيها مارك جونجر عن الاختلافات بين طريقة تفكير المرأة وطريقة تفكير الرجل، وبغض النظر عن صحة أفكاره تلك وصياغتها الكوميدية، إلا أن فكرة “الصناديق” المنفصلة استهوتني.
قمت بتسمية صناديق عقلي المتخيلة، وأصبحت أًخمن أحجامها وأشكالها، والقصص التي بداخلها. لا أستطيع أخذكم في جولة عبر كل الصناديق، لكن سأحاول الحديث عن بعضها.
سأتحدث أولاً عن صندوقي المفضل، وهو “الفراغ” وهو الذي تحدث عنه جونجر بشكل حرفي “Nothing Box”.
الفراغ صندوق متوسط الحجم (أفهم أن الفراغ لا يستلزم مساحة، ويمكن أن يكون الصندوق شديد الصغر، لكنه متوسط الحجم لسبب أجهله، كما أجهل أن يكون للفراغ حيز، صندوق). أقوم باستخدامه عدة مرات يومياً. في هذا الصندوق الفارغ أسرح أوقات طويلة، وعندما يسألني أحدهم: بماذا تفكر؟ وأجيبه “لا شيء” أكون صادقاً تماماً لحظتها، أو أظن ذلك على الأقل.
الصندوق الثاني كثير الاستخدام هو “قصص تنساها خلال 24 ساعة” وهو صندوق بمثابة سلة مهملات محددة الوقت، تبرمجت وفق شعار “المحتويات تحذف بعد 24 ساعة”. كل اللحظات الحرجة العابرة، هفوات اللسان المؤذية، الحماقات اليومية المعتادة، توضع في هذا الصندوق. بعضها يحذف فعلاً بعد 24 ساعة، لكن بعضها يبقى في الذاكرة بصورة غامضة، كجرثومة أو فايروس خامل، قد ينشط في أي لحظة، قد يتحول لصناديق أخرى رغم إرادتي، وهذا مزعج.
الصندوق الثالث اكتشفته مؤخراً، يحمل عنوان “مشاريع ملعونة”. لا أعرف إن كان صندوقاً قديماً اختار أن يثور فجأة، أو صندوق جديد كلياً.
كانت المشاريع المؤجلة في السنوات السابقة تهيم على وجهها في عقلي دون مستقر. اتعثر بها أحياناً بين الصناديق، ويطويها النسيان غالباً. لكن بعد بلوغي الثلاثين غيرت “مشاريعي المؤجلة” من نمط تعاملها معي، وأصبحت أكثر قوة وتماسكاً، وتجمعت في صندوق بشع وثقيل، يقلق راحتي كل لحظة، أصبحت لعنة. لا أظن أنني قادر على تجاهلها بعد الآن. لن أقول أنه صندوق متعفن كجثة، لكنه معتم، ولا يشبه الشعارات المشرقة التي تطلق على المستقبل عادة، ذلك الذي لن نراه على الأرجح بسبب حرب نووية قريبة، مؤجلة، مثل مشاريع هذا الصندوق.
أكثر الصناديق إثارة للجدل في عقلي، صندوق “النسيان”. وهو يحوي كل ما لا أريد تذكره. عندما أقذف شيئاً في صندوق النسيان، يبدأ بمطاردتي. رائحته تصبح في كل خلاياي. أستطيع أن أراه في كل النواحي. صندوق النسيان هو أكثر صناديقي اضطراباً، وكلما ألقيته بعيداً في مخازن العقل، وجدته مرتزاً في صدارة الأشياء. صندوق النسيان ضد اسمه، وكأنه صندوق التذكر الأبدي.
للصناديق روح، ولها مادة تكونها. للصناديق رائحة، وسطح يمكن لمسه. للصناديق صوت تصدره عند ارتطامها بأرضية مكان، وبعضها يعزف كعلبة موسيقى، وأخرى تنشز وتزعج مثل التنك . للصناديق تاريخ صلاحية لا نعرفه. للصناديق لون، بل لها طعم يمكن تذوقه، يشبه طعم أشجار الغابات الاستوائية. للصناديق أنظمة سلامة، ومخارج طوارئ، لو أخفقنا في صيانتها قد نخسر كل شيء، فالصناديق في نهاية المطاف، قابلة للاشتعال. لكن، هل تعرفون الفوضى الهائلة التي تحيط بكل هذه الصناديق لحظات ما قبل النوم؟
January 16, 2018
عشرة أغاني عراقية عليك أن تسمعها قبل أن تموت
يمكن وضع قوائم تحوي مئات الأغاني العراقية الرائعة، لا 11 أو 12 أغنية كما فعلت في هذه التدوينة. لكن الاختيار هنا شخصي إلى حد كبير.
قد يتقاطع اختياري مع تفضيلات الفنان أو الجمهور، على الأرجح سيعتبر جمهور فؤاد سالم أغنية (مشكورة) أهم أغانيه، لكن هذا لا يحدث كثيراً في هذه القائمة، ولم اختار الأغاني وفق هذا المعيار. اخترت أغنية “مسافرين” لياس خضر، بينما جمهور ياس خضر قد يفضل “حن وأنا احن” وقد يفضل ياس أغنيته “اعزاز” كما يقول في مقابلاته. اخترت أغنية “البارحة” لسعدون جابر بينما الفنان قد يفضل “يا طيور الطايرة” وجمهوره قد يفضل “عشرين عام”.
اخترت أغنية فاضل عواد “حاسبينك” ليس لأنها أجمل من “لاخبر” فقط، ولكن لأن الأغنية الأخيرة مشهورة جداً، وأشعر أن “حاسبينك” لم تُسمع كما يليق بها أن تُسمع. وهذا ينطبق على ناظم الغزالي أيضاً، والذي لم أختر له أغنية رغم أنه واحداً من أهم الفنانين العراقيين في القرن العشرين، وهذا مرتبط بمحدودية القائمة وشهرة الغزالي الهائلة. وهذا ينطبق على سليمة مراد، ومحمد القبنجي، وغيرهم من الفنانين العراقيين الكبار الغائبين عن هذه التدوينة.
استبعدت مطربي الريف العراقي رغم روعة أغانيهم، حضيري بوعزيز وداخل حسن يستحقون أيضاً أن يكونوا في القائمة، ولكن هذا لم يحدث. ربما لأن المزاج العام الذي حكم هذه القائمة أن تكون مختصرة، وطربية، وبتسجيلات واضحة قدر الإمكان.
ترددت كثيراً في وضع أغنية ليوسف عمر في القائمة، رغم كونه أفضل فنان عراقي عندي مطلقاً. والسبب أن صوته وأسلوبه في الغناء قد لا يعجب الكثير، وتسجيلاته الواضحة قليلة، لكن هذه القائمة أيضاً لا تخضع لهذا المعيار.
لا يوجد معيار يتعلق بالزمن، أو نوع الأغاني. كما أن الترتيب “شبه” عشوائي.
كنت أود الكتابة عن كل أغنية بصورة محددة، لكنني تراجعت، الكتابة عن الأغاني صعبة جداً، خاصة تلك التي تتعلق بمشاعرك تجاه هذه الأغنية أو تلك، لذا تركت الأغاني “عارية” أدناه.
ياس خضر – مسافرين
https://soundcloud.com/ali-mansoury-1/sbcaewkisggd
فاضل عواد – حاسبينك
https://soundcloud.com/dayes-m/rgpowsjbvg63
رياض أحمد – مرة ومرة
https://soundcloud.com/maharezeq/vr2vlscsrtc4
حسين نعمة – شكَد صار أعرفك
https://soundcloud.com/ab_eer-1/p0sx7vz17plp
حسين الأعظمي – مقام نهاوند
https://soundcloud.com/shadymasood/maqam-nahawand-hussein-al-adhami
حميد منصور – سلامات
https://soundcloud.com/balrashed5/lpqvigvn63iz
فؤاد سالم – مشكورة
https://soundcloud.com/10planet/qrzqmviypgjf
سعدون جابر – البارحة
https://soundcloud.com/balrashed/i2atk8bmvyfo
طالب القرغولي – الخلخال
https://soundcloud.com/balrashed555/hkc6fjidytpi
قحطان العطار – على الميعاد
https://soundcloud.com/bassam-alkhalde/uxnf074uxo3z
يوسف عمر – مالي أرى القلب (مقام نهاوند)
https://soundcloud.com/balrashed55/ppo4jtdmuj0s
صالح الكويتي وداود الكويتي – وين العهد
https://soundcloud.com/saad_f/wain_al3had
January 12, 2018
وعود ميلان كونديرا في الرواية – الجهل
لم أشعر برغبة الكتابة عن رواية، مثل رواية ميلان كونديرا “الجهل”، العمل الذي شعرت به يطاردني لأسابيع، رغم قصره. لدي حب خاص لكونديرا رغم أنني لم أقرأ له – قبل الجهل – إلا عملاً واحداً، هو “كائن لا تحتمل خفته” أو “خفة الكائن التي لا تحتمل” باختلاف الترجمات التي فشلت غالباً في ترجمة عنوان الرواية الذي يتحدث عن “الكينونة” لا “الكائن” إن صحت ترجمة (Be) الإنجليزية إلى كينونة، لعدم وجود مرادف “مباشر” لها في اللغة العربية.
راودني السؤال التقليدي، الذي أظنه يصادف أي قارئ لكونديرا، ويتحدث عنه نقاده باستمرار، أعني ذلك المتعلق باستطراداته الفلسفية، وشخصياته التي تبدو غالباً بمستوى ثقافي واحد. وهنا أتذكر أن الروائي السعودي فهد العتيق، وهو بالمناسبة قد كتب إحدى أفضل الروايات السعودية رغم قصرها، أعني “كائن مؤجل”، تحدث مراراً عن تلك “المشكلة” عند كونديرا، مرة قبل سنتين أو ثلاثة إن لم تخني الذاكرة، ومرة قبل قرابة العشرة سنوات.
في رواية “الجهل” يبدو التنظير أكثر وضوحا، ومباشرة، من رواية “خفة الكائن التي لا تحتمل” بسبب الموضوع على الأرجح والذي يدور حول الغربة، وبسبب قصر الرواية. تداخل الأصوات في الرواية يصل لحدودة القصوى، تشعر هنا أن كونديرا يتكلم بنفسه، وهنا الراوي، وهنا الشخصية، لكن كل الأصوات لا تختلف عن كاتبها في طريقة التفكير، كما تشعر أن الشخصيات تتوافق ثقافيا، أو بتعبير أخر “كلهم فلاسفة” كما يعبر العتيق إن لم تخني الذاكرة. لكن السؤال فعلاً: ما المشكلة؟!
صحيح أن هناك نظرة كلاسيكية للرواية، تركز على تباين الشخصيات، وعمقها، وغياب الاستطرادات والتنظيرات المباشرة باعتبارها مملة، لصالح الحبكة والسرد والتنوع والعمق في القص والرواية، إلا أن وعود كونديرا تبدو مغايرة، فهو يقول لك أنه يكسر كل هذا، ويقدم تنظيراً محضاً تارة، وشخصيات متشابة تارة أخرى، واستطرادات فلسفية مطولة، ويستشهد بكتّاب وقواميس وكتب في روايته، إلا أن هذا لا يقلل من قيمة روايته!
وكأن وعود كونديرا أن يكتب بشكل يخالف القواعد، ليقول أنه لا توجد قواعد، وهذا صحيح. ربما يقوم كاتب بالكتابة بنفس الطريقة، لكننا نعتبر عمله تافهاً ومملاً، ومليئاً بالحشو والاستطرادات التي بلا قيمة، ثم نعود للحديث عن القواعد، وهذا يحدث أيضاً.
ربما نجد نفس هذه الملامح في روايات أخرى، إلا أننا لا نعتبرها سمة رئيسية كما نتحدث عنها في أعمال كونديرا. إن لم أكن واهماً، فقد قام بهذه الاستطرادات الفلسفية جوزية ساراماغو في رواية “قايين” وربما في “انقطاعات الموت”. في رواية “قايين” كان صوت ساراماغو صاخباً، وساخراً، وحاضراً بشكل مكثف في الرواية.
في رواية “الجهل” يتحدث كونديرا عن الغربة والوطن، والعودة بعد طول غياب. وتبدو استعارة الجهل لوصف الغربة ملفتاً ومثيراُ، يبدأ كونديرا روايته وكأنها كتاب لغوي، يتحدث فيه عن جذور كلمة غربة واستعارتها في لغات مختلفة، يكتب: “يبدو الحنين كأنه مكابدة الجهل. أنت بعيد ولا أعرف كيف أصبحت. بلدي بعيد ولا أعرف ما يحدث فيه”. ثم تأتي قصة مهاجرين من التشيك، هاجرا إلى فرنسا لعقدين من الزمن، ثم بعد انهيار النظام الشيوعي في براغ جاءت لحظة مواجهة أسئلة الوطن والغربة والعودة والمهجر من جديد. لحظة إعادة تعريف كل شيء.
December 23, 2017
تزفيتان تودوروف الذي تنبأ بكل شيء
ورحل الفيلسوف البلغاري – الفرنسي تزفيتان تودوروف، في الوقت الذي رأى، قبيل وفاته، كل مخاوفه التي قضى عمره في التحذير منها، تتجسّد أمامه في أكبر الديمقراطيات الغربية، الولايات المتحدة.
رُسمت توجهات تودوروف باكراً، عندما قضى سنواته الأربع والعشرين الأولى في ظل نظام شمولي، هو النظام الشيوعي البلغاري، قبل أن يغادر صوفيا، ليستقر في فرنسا، ويصبح أبرز مفكريها، أو أبرز “مؤرخ أفكار”، كما يصف تودوروف نفسه، وهو الذي انطلق من النقد والأدب، للدخول إلى تأريخ الأفكار والإيديولوجيات.
يمثل تودوروف حالة بارزة عالمياً، بتمسكّه بـ “قيم التنوير”، في الوقت الذي بدا الكثير بتجاوزها، إما رفضاً لـ “المركزية الأوروبية”، باعتبار التنوير حالة غربيةً لا تحمل أبعاداً خارج القارة القديمة، أو لأن التنوير أصبح سلطة أخرى، أو وهماً آخر، و”سردية كبرى” يجب أن تذوي، في وقتٍ بدأ البشر فيه بالتحرّر من أوهام كثيرة بعد الحرب العالمية الثانية، كما في “سرديات” ما بعد الحداثة.
إلا أن تودوروف نافح عن الأنوار، في مقابل تحريرها من سياقها الأوروبي، ومحاولة إعطائها بعداً عالمياً، فكانت رؤيته قائمة على “حضارةٍ” يمكن أن يشترك فيها جميع البشر، في الوقت الذي لا تنفي هذه الحضارة ثقافات البشر وهوياتهم وتعدّدها. يكتب تودوروف في “الخوف من البرابرة”: لا توجد إنسانية شاملة. .. لو حرمنا البشر من أية ثقافة خاصة، فإنهم بكل بساطة لن يعودوا بشراً.
رأى تودوروف مبكّراً مهدّدات الديمقراطية في عالم ما بعد انهيار جدار برلين. واعتبر في كتابه “أعداء الديمقراطية الحميمون” أن الديمقراطية مهدّدة من الداخل. صدرت الطبعة الفرنسية الأولى من الكتاب في 2012، والترجمة الإنجليزية في 2014، أما الطبعة العربية فكانت في 2016، ليظهر الكتاب وكأنه نبوءة “تفصيلية” للتحذير من انهيار الديمقراطية في أوروبا وأميركا تحت وطأة صعود اليمين المتطرف، والخطاب الشعبوي، إضافة إلى هيمنة “الرأسمالية المتوحشة”، باعتبارها أبرز مهدّدات الديمقراطية من وجهة نظر تودوروف الذي اعتبر أن “غطرسة” الديمقراطية العنوان العريض لنقاط ضعفها. فبعد انهيار جدار برلين، وسقوط الاتحاد السوفييتي، لم يعد هناك خطر خارجي كبير يهدّد الديمقراطية التي هزمت خلال قرابة نصف قرن أشد أعدائها قوةً وصلافةً: النازية والشيوعية.
حارب تودوروف على الجبهة التي ترفض اعتبار الإسلام العدو البديل للديمقراطية بعد نهاية الحرب الباردة، وعارض بشدة أفكار صامويل هنتغتون عن صراع الحضارات، وردّ ببساطة: الصراع بين دول، ومصالح سياسية، لا بين ثقافات وأديان.
يرى تودوروف أعداء عدة للديمقراطية، يتحدّث عن بعضها، أو عن التي يصفها بالأقرب إلى تجربة حياته في ظل نظام شمولي. يتحدّث عن “الشعبوية”، والتي يراها مضادّة للعقلانية، وساحقة للحريات الفردية. وكما يرى الخطر في الليبرالية القصوى أو الليبرالية المتطرّفة (Ultra Liberalism)، والتي جعلت الاقتصاد والرأسمالية المتوحشة محور كل شيء، في هيمنةٍ على السياسة والإعلام والقضاء، بدل أن تصبح هذه المجالات مفصولةً عن بعضها، كما يشير إلى خطر الأيديولوجيات الخلاصية (Messianism).
يأسف تودوروف على تغيّر مفهوم “الحرية” في أيامه، حتى أصبحت أحزابٌ أوروبيةٌ كثيرة تجعل الحرية شعاراً لها، تتبنّى سياساتٍ معاديةً للأجانب، أو ترسخ أجندة الإسلاموفوبيا، أو تتبنى أيديولوجية وطنية متطرّفة، بينما يرى الحرية مرحبةً بالتعدّدية وقائمة على القبول بالاختلاف. لكن التحول الأهم الذي شهده تودوروف، عطفاً على موضوعه، سيكون صعود اليمين المتطرف في أوروبا الغربية من جهة، وتربع الخطاب الشعبوي على سدة الحكم في أكبر الديمقراطيات الغربية، الولايات المتحدة، بعد دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
نُشرت في 9 فبراير 2017
Filed under: مقالات


تزفيتان تودوروف يخوض الرعب والأمل في “الخوف من البرابرة”
لا يذهب تزفيتان تودوروف في كتابه “الخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات” إلى حد نفي البربرية كحالة كما يقول شتراوس “البربري هو من يؤمن بوجود البربرية” بل على العكس من هذا يرفض تودوروف عبارة شتراوس ويؤكد على وجود البربرية، لكنه يحددها بمحددات واضحة، فالبربرية حسب تودوروف هي حالة نفي إنسانية الآخر، وهي وصف لوضعيات وأعمال – كما الحضارة تماما – أي أنها لا تعطي توصيف ثابت للإنسان أو وصف جوهراني لهوية الشعوب.
في تلك المعمعة من المصطلحات المتشابكة والمتداخلة، يحاول تودروف أن يكون أكثر تحديدا، إذ يفرق بين الحضارة والهوية، باعتبار الحضارة تمثل ما هو مشترك إنساني قيمي، والهوية تمثل ما هو ثقافة محلية خاصة، ويؤكد أهمية الثقافة بقوله “لا يوجد إنسانية شاملة: لو حرمنا البشر من أية ثقافة خاصة، فإنهم بكل بساطة لن يعودوا بشرا” هنا يتم الحديث بالتوازي عن ما هو خاص بالإنسان كمكون ثقافي، وما هو مشترك إنساني كحضارة شاملة.
في ملاحظة طريفة تفسر الكثير من الأحداث حولنا، يشير تودوروف إلى أن “الخوف من البرابرة هو الذي يُخشى أن يحولنا إلى برابرة” حيث يحدد الخوف كمبرر لارتكاب أبشع الجرائم في حق البشرية، باسم حماية الإنسان لنفسه أو من يحب، من الآخرين، وكيف تحول هذا المبرر إلى أفعال قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية، ويشير هنا إلى التغيرات التي ضربت العالم الغربي بعد أحداث سبتمبر، وكيف أنه من أجل سياسات الحماية والنضال من أجل قيم الديمقراطية “نجد أنفسنا مدفوعين للتخلي عنها!” على حد تعبير تودوروف.
يحاول تودوروف تحليل الخوف من الإسلام في أوروبا، ويعيد المسألة إلى جذورها التاريخية لا يكتفي بتسطيح المسألة من خلال الحديث عن أحداث آنية. حيث يشير في معرض كلامه إلى الجذور القديمة لصراع الإسلام مع المسيحية، والحروب الصليبية، والاستعمار الأوروبي الحديث، والهجرة، وبالتأكيد تحكّم المسلمين والعرب بأهم سلعة في العالم اليوم “البترول” محددا معنى التحضر بأنه الإقرار بإنسانية الأخر، وذلك لا يتحقق إلا عبر مرحلتين “نكتشف بأن للأخرين أنماط عيش مختلفة عنا” والمرحلة الثانية “نتقبل بأنهم يتشاركون معنا بالإنسانية نفسها” وإذا تعريف تودوروف للتحضر قائم على الوعي بالاختلاف والتعدد والقبول به بل اعتباره جزء من إنسانيتنا. لذا يحدد الإنغلاق على الذات كمؤشر من مؤشرات البربرية، بل يحدد الانتقال من البربرية إلى الحضارة بأنه “الانفصال عن الذات للتمكن من معاينتها من الخارج كما بأعين الأخرين” أي أن التحضر قائم على تفهم الأخرين وتخيل أنفسنا محلهم لتفهم دوافعهم وأنماط عيشهم. ويؤكد هنا بأن الحروب لم تقم بسبب التعددية، بل بسبب عدم تسامح أصحاب النفوذ.
ينتقد تودوروف في معرض حديثه عن الحضارة والبربرية مفكري الأنوار الرافضين للنسبية الرافضين للتجديد في قيم الأنوار الأساسية ويصفهم بأنهم مجرد مدافعين عن الثقافة الغربية التي يرونها متفوقة. ويعتبر هؤلاء بأنهم يتنكرون لتراث الأنوار الحقيقي القائم على شمولية القيم وتعددها في آن.. ففي فصل الهويات الجماعية يكتب تودوروف مستنكرا تأسيس “وزارة الهوية الوطنية” في فرنسا، وتدخلها فيما يسمى “سياسة الذاكرة” من خلال الحديث عن من يستحق التمجيد في التاريخ الفرنسي ومن لا يستحق، وكيف أن هذه السياسة تناقض علمانية الدولة الفرنسية إذا تقوم سياسات تلك الوزارة على تحديد ما يجب على المواطنين أن يعتقدوه !
يؤكد تودوروف “ليست الهويات بحد ذاتها هي التي تتسبب بالنزاعات، وإنما النزاعات هي التي تجعل الهويات خطرة” وهنا يعود ليتحدث عن الإسلاميين والإسلام، ويشجب استخدام لفظة “مسلم معتدل” وكأن المسلم بأصله وجوهره متطرف! وهنا يشير تودوروف إلى أن المشكلة لا تقوم على أسس اختلاف في التأويل الفقهي داخل المجال الإسلامي بين تأويلات متطرفة ومعتدلة، بقدر ما تقوم على أساس الشعور بالقهر والإذلال، لذا يعتبر أن حل الخلاف مع المسلمين ليس دينيا ولا ثقافيا وإنما حل سياسي. وهنا يشير تودوروف إلى أزمة الضواحي في فرنسا وإندلاع العنف سنة 2006م وكيف أنها إلصقت في فرنسا بالإسلاميين رغم أن كل المؤشرات أكدت على أن الدوافع طبقية ولا يود أي حركات منظمة لذلك العنف، حتى أن أكثر الفرنسيين تطرفا جان ماري لوبين نفى أن تكون تلك الأعمال التخريبية قامت لأسباب دينية.
يشير تدوروف إلى حالة “فقدان الهوية الثقافية” خاصة بين أبناء المهاجرين من الجيل الثاني في فرنسا، فلا هم الذي ورثوا هويتهم الأم ولا اندمجوا واكتسبوا هوية المحيط الجديد الذي ينتمون إليه. وهذا ما يفسر صعوبات إندماجهم في المجتمع الفرنسي. وهنا يشير إشارة طريفة بقوله “إن الأجانب الذين يود هؤلاء الفتية تقليدهم ليسوا أئمة القاهرة وإنما مغنوا الراب في لوس أنجلس.”
يتداخل في كتاب تودوروف الحديث عن الهوية والثقافة والدين، مع الطبقة وصراع البروليتاريا ضد الرأسمالية، والخوض في تاريخ الاستشراق ومحاضرة رينان “ما هي الأمة؟ ” ثم يعود لأحداث سبتمبر واحتلال العراق وفضائح أبو غريب وجوانتنامو وسياسات التعذيب في الولايات المتحدة الأمريكية التي أقرتها الحكومة إبان انتخاب جورج بوش الابن.
يطرح تودوروف في حديثة عن “الحركات الإسلامية والتوتاليتارية” مقارنة طريفة بين الحركات الإسلامية والتنظيمات الشيوعية، فيعتبر كلاهما يشكوا من الظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي، وجميعهم يدعون الدفاع عن العالم الثالث في وجه الهجمة الإمبريالية الغربية، وأنهم لا يطمحون إلى مصالح خاصة، ويضحون بأنفسهم من أجل الصالح العام، وأنهم طليعيون وتقدميون ويقومون بتنظيم حركتهم هرميا من الخلايا حتى رأس المرشد. بالإضافة بالتأكيد إلى أفكارهم حول الأممية والوحدة الإيديولوجية وتخطي الحدود. ثم يبدأ بسرد الاختلافات بين الحركات الإسلامية والشيوعية، ابتداء بالموقف من الدين وانتهاء بالصراع على السلطة.
أما في حديثه عن الهوية الأوروبية يشير تودروف إشارة مثيرة إلى تعددية هذا التراث واختلاف بل تناقضه، فيقول على سبيل المثال ” إن فكرة المساواة بين الجميع وصلت إلينا من التاريخ الأوروبي، ومع ذلك فإن فكرة الاستعمار ليست غريبة أبدا عن هذا التاريخ”. كما يقول “إن الحماس الديني كالعلمانية ينتميان إليه (=التاريخ الأوروبي) بنفس القدر”.
يختم تودوروف الكتاب تحت لافتة “أبعد من الثنائيات” حيث يحاول الخروج من تلك الثنائيات الخير /الشر.. البربرية / الحضارة .. الإسلام / الغرب ..الخ باعتبارها غير حقيقية ولا تفيد تحليل الواقع، يقول تودوروف ” إن الانقسامات الثنائية السهلة بين الأنوار والظلمات، العالم الحر والظلامية، التسامح الرحب والعنف الأعمى تفيدنا عن غطرسة القائلين بها أكثر مما تفيدنا عن تعقيدات العالم الحالي” كما يشخص تودوروف في كتابة مسألة الهوية والحضارة والبربرية على عدة مستويات من خلال خمسة فصول وخاتمة، في الفصل الأول “البربرية والحضارة” يقدم صيغة لمحاولة الفهم بالحديث عن الحضارة والبربرية والأنوار والثقافات والهويات والاستعمار ..الخ. أما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان “الهويات الجماعية” فيناقش تعدد الثقافات في عالمنا المعاصر ومسائل القيم والدولة والأمة. وفي فصل “حرب العوالم” يحاول تودروف تشخيص ما يحدث اليوم، صدام بين حضارات أم حروب دينية أو معارك سياسية، حيث يحاول مقاربة الحركات الإسلامية والحرب ضد الإرهاب. ويناقش خلال هذا الفصل عمليات التعذيب في أبو غريب وجوانتنامو وكيف كانت سلوكيات بربرية بامتياز رغم صدورها عن دول يفترض بأنها متحضرة.
ثم في فصل “الإبحار في قلب المخاطر” يواجه تودروف بالرصد والتحليل الساحة الأوروربية من الرسوم الكاريكاتورية ضد الرسول عليه الصلاة والسلام وحتى حادثة اغتيال أحد الهولنديين المعادين للإسلام. ثم يأتي الفصل الأخير بعنوان “الهوية الأوروبية” يتحدث عن الاتحاد الأوروربي سياسيا وثقافيا، ما يجمع هذه الدول وما يفرقها، وما هو مستقبلها.
كتاب الفيلسوف الفرنسي تزفيتان تودوروف “الخوف من البرابرة : ما وراء صدام الحضارات” من ترجمة الدكتور جان ماجد جبور وإصدار هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ضمن مشروع كلمة للترجمة. صدرت الطبعة الأولى سنة 2009م ويقع الكتاب في 221 صفحة من القطع الكبير.
جريدة الرياض
27 – 10 -2012
http://www.alriyadh.com/779565
Filed under: قراءات, عروض كتب


April 29, 2017
انقلاب المئة يوم على “القوميين البيض”: ترامب بقبضة الجنرالات
يمكن تحديد قوتين رئيسيتين في إدارة ترامب، تتبنيان رؤى وأجندات متناقضة جذرياً: الأولى تتمثل بـ”القوميين البيض”، وتضم طيفاً متنوعاً من المستشارين العنصريين الشعبويين، والذين تتقاطع أفكارهم ورؤاهم مع اليمين البديل الأميركي ومجموعات النازيين الجدد، وأبرزهم وأكثرهم حضوراً هو كبير استراتيجيي البيت الأبيض ستيف بانون، وأهمهم في المناصب التنفيذية وزير العدل والمدعي العام جيف سيشنز. أما التيار الثاني فيمثله “جنرالات ترامب” من خلال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ووزير الأمن الداخلي جون كيلي، ومستشار الأمن القومي إش آر ماكماستر، ورئيس هيئة الأركان جوزيف دانفورد. هؤلاء الجنرالات هم حراس السياسات الأميركية التقليدية “الصقورية” والتي يمكن تحديد خطوطها العريضة الثابتة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي على الأقل. وتتقاطع رؤى هذا التيار بصورة كبيرة مع التوجّهات الجمهورية التقليدية.
“القوميون البيض”
ليس بالضرورة أن يكون المحسوبون على تيار “القوميين البيض” منخرطين بصورة مباشرة بالمجموعات النازية الجديدة الأميركية، والتي يُتهم مدير “معهد السياسة الوطنية” ريتشارد سبنسر بنسج علاقات معها، أو مخلصين لتعاليم منظّر القومية البيضاء الأبرز، جاريد تايلور. لكن هؤلاء يحملون رؤية عرقية للهوية الأميركية، تمقت المهاجرين والإسلام، ويتبنون رؤية عنصرية مركزها العرق الأبيض، والتقليد المسيحي أو المسيحي-اليهودي باعتباره العمود الفقري لـ”الحضارة الغربية”.
يمثّل التيار المؤمن بهذه الأفكار في إدارة ترامب، كبير استراتيجيي البيت الأبيض ستيف بانون، والذي كان وما زال موقعه الإلكتروني (بريتبارت) ناطقاً باسم “اليمين البديل” الأميركي، الناقم على الاستبلشمنت في واشنطن، والذي يتبنّى رؤى عنصرية عرقية، علاوة على تعزيزه “رهاب الأجانب” والإسلاموفوبيا. يمكن اعتبار بانون قريباً أيضاً من “حزب الشاي” من خلال تبنّيه سياسات اقتصادية تدفع باتجاه “حكومة الحد الأدنى” إضافة إلى معارضته لهيمنة نخب “وول ستريت”، و”نخب دافوس” أو “الرأسمالية الدولية” التي يراها لا تهدد الاقتصاد الأميركي فحسب، بل “الحضارة الغربية” برمتها. من أقوى شخصيات هذا التيار في إدارة ترامب، وزير العدل والمدعي العام جيف سيشنز، المعروف بعنصريته وتعصبه عندما كان قاضياً في ألاباما، والذي رُفض ترشحه من قبل الكونغرس قاضياً فيدرالياً للولاية في 1986 بسبب اتهامه بالعنصرية ضد السود.
ووصف سيشنز “الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين”، والتي تُعنى بسياسات التمييز الإيجابي للسود، بأنها “غير أميركية” باعتبارها لا تمثّل الأميركيين الأبيض. كما عُرف وزير العدل بسياساته التي أعاقت تصويت الأميركيين السود في ألاباما. وقال سيشنز ذات مرة عن المنظمة العنصرية المتطرفة “كو كلوكس كلان” إنه “كان يعتقد أنهم على حق، حتى علم أن بعضهم يدخن الحشيش” في إشارة لرفضه تدخين الماريوانا، لكن سخريته تحمل أيضاً معنى آخر، أنه يقلل من قيمة الجرائم التي ارتكبتها تلك المنظمة التي دُشنت بعد الحرب الأهلية الأميركية في 1865 وقام أفرادها بقتل آلاف السود وسحلهم في الشوارع وتعليقهم على الأشجار، خصوصاً في حقبة الحربين العالميتين.
الشخصية الثالثة المحسوبة على هذا التيار، مقربة من سيشنز وبانون على السواء، وهي كبير مستشاري الرئيس، الشاب ستيف ميلر، والذي لا يتجاوز عمره الواحد والثلاثين. عمل ميلر مع سيشنز عندما كان في مجلس الشيوخ لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الدول اللاتينية من الحصول على الجنسية الأميركية. وعُرف ميلر المنحدر من أسرة ليبرالية-يهودية بعلاقته مع أحد أبرز المتهمين بعلاقات مع المجموعات النازية الأميركية، ريتشارد سبنسر، عندما كانا زميلين في جامعة ديوك. إلا أن ميلر يرفض ربطه بسبنسر. كما عُرف عنه حماسته للأفكار المحافظة المتطرفة لديفيد هورويتز، خصوصاً تلك المتعلقة بكراهية المسلمين، ودعا ميلر لاستضافة هورويتز في جامعة ديوك عندما كان طالباً فيها.
يُعتبر ميلر، الذي يُتهم بالوقوف وراء قوانين ترامب المتعلقة بمنع دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، من رافضي “التعددية الثقافية”، ووصفها بأنها “تقوّض أميركا”، نافياً أن تكون الولايات المتحدة “أمة مهاجرين”. كتب ميلر أن “أسامة بن لادن سيشعر بالترحاب في ثانوية سانت مونيكا”، في سياق انتقاده لما يراه تسامحاً “غير مقبول” مع الأعراق والأديان المختلفة. ويرى ميلر أن مهمة أوروبا وأميركا اليوم “حماية الحضارة والثقافة من غير المنتمين إلى التقليد اليهودي-المسيحي”. وهو من المؤكدين أن “الحرب على الإرهاب” يجب أن تكون حرباً دينية ضد الإسلام. وفي عام 2007، وخلال دراسته في جامعة ديوك، أسس ميلر “مشروع التوعية بالإرهاب” للتحذير من “الجهاديين الإسلاميين” و”الفاشية الإسلامية” للحديث عن حماية “الحضارة الغربية” من الإسلام. وبعد رفض وسائل إعلامية نشر إعلانات لمشروعه، تحدث ميلر عن أهمية “تسمية العدو باسمه” في حديثه عن الإسلام.
كتب ميلر أثناء دراسته الجامعية: “تسمع بصورة متكررة أن الإسلام دين سلام، لكن من غير المهم كم مرة يتكرر هذا الوصف، لن يستطيع التكرار تغيير حقيقة أن ملايين المسلمين الراديكاليين سيحتفلون بمقتلك لسبب بسيط، لكونك مسيحيا أو يهوديا أو أميركيا”. انضم ميلر لحملة ترامب في يناير/كانون الثاني 2016، في الوقت الذي كان فيه سيشنز أول جمهوري يدعم ترامب علانية. لكن الرئيس الأميركي يُنتقد لاختياره ميلر في طاقمه الاستشاري، بسبب عنصريته وأفكاره المتطرفة، وصغر سنّه وانعدام خبرته السياسية.
أما الشخصية الرابعة المحسوبة على تيار القوميين البيض في إدارة ترامب، فهي المستشار المساعد في البيت الأبيض، سيباستيان غوركا، المنحدر من أصول هنغارية، والمولود في لندن سنة 1970، والذي تم تداول اسمه عربياً على نطاق واسع أخيراً بعد تسريبات عن خططه لتقسيم ليبيا إلى ثلاث دول. يخدم غوركا ضمن طاقم مستشار الأمن القومي (الذي شكّله الجنرال المستقيل مايكل فلين)، ويُتهم بمعاداة السامية، وتبنّيه رؤية مسيحية-عسكرية تنتمي للتقليد القومي الهنغاري، علاوة على تطرفه ضد الإسلام، وعلاقته بحزب “فيتيزي ريند” (Vitezi Rend) الهنغاري المتعاون مع الألمان إبان الاحتلال النازي، والمساهم في إبادة اليهود الهنغاريين.
تعود علاقة غوركا ببانون إلى عمله محرراً في موقع “بريتبارت”، منبر اليمين المتطرف. وأثار ارتداء غوركا ميدالية حزب “فيتيزي ريند” الهنغاري خلال حفل تنصيب ترامب الكثير من الجدل في الولايات المتحدة، بسبب تعاون الحزب مع النازيين وتورطه في جرائم ضد اليهود، إلا أن غوركا اعتبر أن ارتداءه الميدالية يأتي تخليدا لذكرى والده “المحارب للشيوعية”. وأصبح غوركا، المنحدر من مهاجرين هنغاريين إلى بريطانيا، مواطناً أميركياً سنة 2012، وكان قد عمل في الجيش البريطاني، ومستشاراً لوزير الدفاع الهنغاري، علاوة على عمله بالتحليل العسكري لوسائل إعلامية مختلفة.
أنصار “أميركا أولاً”
يُعتبر بانون وميلر من أنصار سياسات “أميركا أولاً”، فيما يتهمان خصومهما بأنهم يعملون لأجندة “غير أميركية”. فالقضايا الأساسية الشاغلة لهؤلاء تتعلق بالوضع الاقتصادي، لذا يعطون أولوية لعداوة الصين، ومنظمة التجارة الدولية، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، باعتبار هذه الجهات والتحالفات تستنزف أميركا اقتصادياً، أو تساهم في إضعاف اقتصادها بصورة مباشرة.
من هنا تأتي رؤية بانون “التحالف مع روسيا ضد الصين” لإخماد ثورة التنين الصيني الاقتصادية، وتبنّي أجندة وطنية حمائية اقتصادياً، تتضمن إلغاء اتفاقية التبادل التجاري الحر مع كندا والمكسيك، علاوة على رغبات بـ”الانكفاء” الأميركي، وإصلاح المجتمع، لتجاوز مشكلات “التعددية العرقية والثقافية” و”انتشار الأفكار اليسارية والاشتراكية” التي يراها خطراً أخلاقياً وسياسياً. إضافة إلى هذا، يرى بانون في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حليفاً له، بسبب توجّهات الرئيس الروسي القومية المتطرفة، وتبنّيه أجندة فاشية مسيحية.
لا يخفي هذا التيار في البيت الأبيض عداءه للإسلام، ورفضه للتوسع الأميركي عسكرياً. فسياسات “أميركا أولاً” تعني عدم التورط في نزاعات دولية، وعدم التدخّل العسكري ضد أي كان بأي حجة. ويمكن اعتبار رؤية ترامب للعالم أثناء الحملة الانتخابية من صياغة هذا التيار. الرؤية القائمة على التحالف (أو التهدئة) مع روسيا، والتصعيد ضد الصين، والتخلي عن حلف شمال الأطلسي والذي وصفه ترامب مراراً بـ”المؤسسة البالية”. وتلك التي لا ترى مشكلة في التحالف مع أي كان ضد “الإرهاب الإسلامي” حتى لو كانت هذه الجهة النظام السوري.
جنرالات ترامب
كان طريق ترامب إلى البيت الأبيض محفوفاً بالجدل والخلافات. فترامب لم يحظَ بإجماع الحزب الجمهوري، إضافة إلى وقوف الإعلام التقليدي والتيارات الليبرالية والديمقراطيين ضده. كما جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية على المستوى الشعبي بفارق كبير لصالح منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، إذ تفوقت بما يقارب الثلاثة ملايين صوت، في الوقت الذي فاز ترامب به بالرئاسة بسبب تفوقه بعدد المندوبين على مستوى الولايات. وواجهت إدارة ترامب الكثير من الفضائح الاستخباراتية، التي تتعلق بتدخّل روسيا في الانتخابات، واتصال أعضاء حملة ترامب الانتخابية بمسؤولين روس. افتقار ترامب للخبرة السياسية، وهو الذي لم يتولَ أي موقع سياسي طوال حياته، والانقسام حوله والفضائح المحيطة بفريقه الانتخابي، جعله يملأ المناصب الحساسة في إدارته بجنرالات من قوات البحرية والجيش، باعتبار المؤسسة العسكرية الأميركية “أكثر احترافية” من سياسيي واشنطن، إضافة إلى أنهم فوق الخلافات الحزبية. كما أن أحداً لا يشكك في أولوية الأمن القومي الأميركي عند هؤلاء، ورؤيتهم غير المتسامحة مع روسيا والصين، أهم منافسي الولايات المتحدة دولياً.
عيّن ترامب الجنرال جيمس ماتيس وزيراً للدفاع، والجنرال جون كيلي وزيراً للأمن الداخلي، وكلاهما من قوات البحرية. كما عيّن الجنرال إش آر ماكماستر مستشاراً للأمن القومي خلفاً للجنرال المستقيل المثير للجدل بسبب علاقاته بالروس، مايكل فلين. وكل من فلين وماكماستر من ضباط الجيش. وهناك جنرال رابع، لم يعيّنه ترامب، لكنه قريب من الدائرة المحيطة به، وهو رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد. وتم تعيين دانفورد من قبل الرئيس السابق باراك أوباما في 2015، ووافق مجلس الشيوخ المسيطر عليه من قبل الجمهوريين آنذاك بشكل تلقائي، فغالباً ما كان الجيش الأميركي، وجنرالاته، موضع إجماع وثقة، طالما كانوا “عسكريين احترافيين” بمعنى عدم تورطهم بخلافات “مستنقع واشنطن” الذي رفع ترامب شعار تجفيفه في حملته الانتخابية.
هذه الدائرة من الجنرالات الكبار، أصبحت مؤثرة في سياسات وقرارات ترامب، بما يتجاوز تأثير “القوميين البيض” في إدارته. فجنرالات ترامب يشرفون بصورة مباشرة على الملفات الأمنية الحساسة، وهم في مناصب تنفيذية رئيسية. بينما يقبع “القوميون البيض” في كواليس البيت الأبيض بمهام ومناصب استشارية، باستثناء سيشنز (وزير العدل والمدعي العام).
تشير مصادر من داخل إدارة ترامب، بحسب صحيفة “واشنطن تايمز”، إلى أن ترامب يستمع لجنرالاته، وينفذ ما يقولون. وترى مصادر مقربة من إدارة ترامب أن وزير الدفاع جيمس ماتيس، ووزير الأمن الداخلي جون كيلي، هما الأقرب للرئيس، والأكثر تأثيراً في سياساته.
وتعيد “واشنطن تايمز” ضعف ترامب أمام جنرالاته لأسباب عدة، أبرزها أنهم “يقرأون أكثر من الرئيس” فهم ليسوا مجرد عسكر، بل منظّرين في الأمن القومي والاستراتيجيات العسكرية. كما أن الرئيس يراهم أرقى من “مستنقع واشنطن”، علاوة على كونهم يمثلون ذروة “النجاح الأميركي” لأنهم من “المؤسسة العسكرية الاحترافية”. كل هذه الأسباب تجعل ترامب ضعيفاً أمام سطوة جنرالاته. وكتبت “واشنطن تايمز” أن “الجنرالين كيلي وماتيس وجدا رجلاً يستمع إليهما، ولا يدعي مثل أوباما والآخرين أنه يعرف كل شيء”. الأمر الآخر الذي يجعل ترامب أسير سياسات جنرالاته في مقاربته للمنطقة العربية، أنهم جميعاً قاتلوا في المنطقة. فالجنرالات الأربعة شاركوا في احتلال أفغانستان والعراق 2001 و2003، ما يعني بنظر ترامب أنهم أكثر قرباً ومعرفة بـ”حربه على الإسلام الراديكالي” بحسب تعبير الرئيس، التعبير الذي يرفضه ماكماستر.
رؤية ماكماستر
شكك مستشار الأمن القومي الأميركي إش آر ماكماستر باحتمال إرسال قوات أميركية إلى الأرض في سورية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتعاون مع “شركائها على الأرض” في سورية. ويأتي تصريح ماكماستر بعد أيام من شائعات تداولتها وسائل إعلامية أميركية حول دفع ماكماستر باتجاه نشر قوات أميركية في سورية لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وربما نظام بشار الأسد، في الوقت الذي أوردت فيه تقارير أخرى معارضة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، مثل هذا التوجه. وينتمي ماكماستر إلى المدرسة العسكرية التي تشكك بإمكانية كسب الحروب عن بُعد، أو من خلال عمليات استخباراتية وضربات جوية من دون تدخّل على الأرض. إذ يرى أن هذا غير ممكن، وأن الحروب، خصوصاً ضد المنظمات الإرهابية، لا تُكسب إلا من خلال التعاون مع المجتمع المحلي، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، وفهم المجتمع وثقافته، مستلهماً تجربته في مدينة تلعفر العراقية بعد 2003.
وفي مقالة لماكماستر نُشرت في “نيويورك تايمز” في 21 يوليو/تموز، أكد أن الولايات المتحدة لم تستفد كثيراً من دروس حروبها السابقة، مشدداً على ثلاث نقاط تتعلق بطبيعة الحرب. أولها “الحرب سياسية” باعتبار أن الحرب “أداة للسياسة وليست فعلاً مستقلاً بنفسه”. كما أنه يؤكد أن الحرب “بشرية”، مضيفاً أن “دوافعها لم تتغير منذ 2500 سنة، وهي الخوف، والشرف، والمصالح”. أما النقطة الثالثة البالغة الأهمية بالنسبة للحرب، فإنها عدم إمكانية الوثوق بها، أو التأكد من نتائجها، لأنها “بشرية وأداة سياسية”. يراجع ماكماستر تجارب الحروب الأميركية الأخيرة، في العراق وأفغانستان، ليؤكد أن “حروباً مثل تلك في أفغانستان والعراق لا يمكن أن تُشن عن بعد”. وفي هذا السياق، تأتي الشائعات حول دعم ماكماستر تدخّلاً عسكرياً على الأرض ضد تنظيم “داعش” متوائمة مع رؤيته للحرب والعمل العسكري، والتي ترتكز على العمل على الأرض بالتشارك مع السكان المحليين.
وشارك ماكماستر في عمليات عاصفة الصحراء 1991، كما عمل في العراق بعد 2003، وأرسل إلى افغانستان في 2010. الرتبة العسكرية لماكماستر أقل من بقية جنرالات ترامب، فلم يحظَ بالنجمة الرابعة، إلا أن وجوده على رأس مجلس الأمن القومي الأميركي يعطيه دوراً كبيراً في التنسيق بين أجهزة الاستخبارات الأميركية، والبنتاغون، والبيت الأبيض.
الجنرالات بمواجهة القوميين البيض
بعد تعيين الجنرال ماكماستر مستشاراً للأمن القومي، قام بإلغاء عضوية ستيف بانون، في مجلس الأمن القومي. كما قام بتعيين الجنرال جوزيف دانفورد، ورئيس الاستخبارات الوطنية دان كوتس، المعروف بعدائه للروس، في المجلس. كان تعيين ترامب لبانون في مجلس الأمن القومي أبرز مؤشرات تنامي نفوذه في البيت الأبيض. وأثار التعيين الكثير من الجدل في حينه، باعتبار بانون شخصية سياسية ذات أجندة متطرفة، ومن الخطأ وجوده في مجلس يفترض أن يقدّم للرئيس رؤى أمنية واستخباراتية تتجاوز الأهواء السياسية والانقسامات الحزبية.
وجاء إبعاد بانون من المجلس مؤشراً إلى تراجع نفوذه أيضاً، في ظل دخول ماكماستر في إدارة ترامب، وتنامي سطوة الجنرالين كيلي وماتيس. وكان كيلي يقف وراء استثناء العراق من قانون حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الأراضي الأميركية، كما نصحه (بحسب واشنطن تايمز) بتجنّب تكرار الإشارة إلى مسألة بناء جدار مع المكسيك.
ويتبنّى ماكماستر رؤية معاكسة تماماً لرؤية “القوميين البيض” وترامب في ما يتعلق بالإسلام. إذ إنه يرى أن “التطرف” لا علاقة له بالدين الإسلامي، الذي يؤكد احترامه. في الوقت الذي يرفض فيه قول كلمة السر المفضلة لدى ترامب “التطرف الإسلامي” لوصف الإرهاب.
إلا أن دلائل وقوع ترامب في قبضة جنرالاته تذهب أبعد من عزل بانون من مجلس الأمن القومي، من خلال تتبّع سياسات البيت الأبيض أخيراً، والتي تمثّل إلى حد كبير عودة للسياسات الصقورية للبنتاغون، في ظل تراجع أجندة “أميركا أولاً” التي حاول “القوميون البيض” رفعها أثناء حملة ترامب الانتخابية وأيامه الأولى في الرئاسة. تراجعَ ترامب عن التهدئة مع روسيا، وبدأ بالتصعيد ضد بوتين في الملف السوري بعد استخدام نظام بشار الأسد للسلاح الكيميائي في خان شيخون، ورد بالقصف بالتوماهوك الأميركي. الحدث يمثّل بحد ذاته قطيعة مع “عقيدة أوباما” وتراجعاً عن أجندة “أميركا أولاً” الرافضة للتورط في صراعات المنطقة العربية، علاوة على أنه تراجع عن شعارات رفض التدخّل العسكري أو ما كانت توصف بـ”السياسات الانعزالية” التي قال محللون إن ترامب قد يتبناها في ظل التفاته لإصلاح الأوضاع الداخلية الأميركية. كما تراجع ترامب عن التصعيد ضد الصين، ووصف لقاءه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ”الممتاز”، معتبراً أن مسألة التجارة سيبحث بها الطرفان لاحقاً. كذلك تراجع ترامب عن انتقاداته لحلف شمال الأطلسي ووصفِه بـ”المؤسسة البالية التي تجاوزها الزمن”، فاعتبر أن الحلف “حصن للسلام والأمن العالمي” في ظل تأييد أوروبي (ألماني وبريطاني وفرنسي) واسع للتصعيد الأميركي في سورية.
لا يمكن عزل سياسات ترامب تلك، عن أمرين رئيسيين: هيمنة الجنرالات على قرارات البيت الأبيض، ومحاولة ترامب الخروج من مأزق التحقيقات بشأن التدخّل الروسي في الانتخابات الأميركية، وعلاقات أعضاء حملته الانتخابية بروسيا، القضية التي أطاحت بفلين، وكادت أن تطيح بسيشنز، وما زالت لعنتها تلاحق أعضاء إدارة ترامب، من غير جنرالاته.
ترامب جاء بشعارات وأجندة سياسية صيغت أثناء الحملات الانتخابية وفق أهواء “القوميين البيض”، تلك الشعارات التي نجحت في إيصال ترامب إلى البيت الأبيض، لكنه فشل في ترجمتها سياسياً من خلال إدارته. فقرار ترامب حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية، ثم ست دول إسلامية، أو ما يعرف بقرار حظر دخول المسلمين، كلها عُطلت من القضاء الأميركي. ومحاولات استبدال قانون التأمين الصحي (أوباما كير) فشلت أيضاً، على الرغم من كون رفض (أوباما كير) محط دعم جمهوريي الكونغرس. كما أن رغبة ترامب بالتقارب مع روسيا أُفشلت، ودفعه للتصعيد مع الصين كذلك. وفي ظل التصعيد ضد كوريا الشمالية والنظام السوري وإيران، يبدو ترامب بحاجة أكثر إلى حلفاء أميركا التقليديين في أوروبا والمنطقة العربية وبحر الصين الجنوبي.
أولويات “القوميين البيض” المتمثلة بإلغاء اتفاقيات التجارة العالمية والانكفاء، وترسيخ سياسات عنصرية في الداخل، لم تعد أولويات الرئيس الأميركي، في ظل تبنّيه سياسات البنتاغون التقليدية تجاه الأمن العالمي. سياسات البنتاغون “الصقورية” ستبهج ترامب أيضاً، فهي تُظهر قطيعة مع أوباما الذي وقف وحيداً ضد جنرالاته الذين تم تحجيمهم خلال فترتيه الرئاسيتين. كما أنها تظهر ولو شعبياً أن ترامب نجح في “جعل أميركا عظيمة” لا عبر إلغاء اتفاقيات التجارة العالمية، وإنما بضربات التوماهوك على سورية، واستخدام “أم القنابل” في أفغانستان، وتحريك ثلاث حاملات طائرات (كارل فينسون ورونالد ريغان ونيمتز) باتجاه شبه الجزيرة الكورية، أي عودة الولايات المتحدة للعب دور “شرطي العالم”.
ترامب: أنا صانع استراتيجيتي
خرج الرئيس الأميركي عن صمته بعد تصاعد الخلافات بين كبير استراتيجيي البيت الأبيض ستيف بانون، وصهر ترامب، جاريد كوشنر، وأدلى بتصريحات قُرئت على نطاق واسع بأنها مقدّمة لطرد بانون من دائرة التأثير في الإدارة الأميركية. وقال ترامب في تصريحات لصحيفة “نيويورك بوست” في 11 إبريل/نيسان الحالي: “يعجبني ستيف، لكن كما تذكر هو لو ينضم إلى حملتي (الانتخابية) إلا متأخراً جداً”. وأضاف الرئيس الأميركي: “لقد هزمت كل أعضاء مجلس الشيوخ وكل حكّام الولايات (المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري) قبل أن أعرف ستيف. أنا صانع استراتيجيتي، ولم أكن لأغير استراتيجيتي لأواجه هيلاري”، في إشارة إلى عدم لعب بانون أي دور هام في صياغة استراتيجية ترامب الانتخابية.
وختم ترامب حديثه للصحيفة بالقول: “ستيف رجل جيد، لكنني أخبرتهما (ستيف وكوشنر) إن لم يصلحا الأمور سأقوم أنا بإصلاحها”. ومن المستبعد أن يقوم ترامب بـ”إصلاح الأوضاع” ضد أهواء صهره كوشنر، ما يضع بانون في دائرة الخطر حتى حين. ووُصف بانون بأنه “رئيس الظل” في البيت الأبيض في أسابيع إدارة ترامب الأولى، إلا أن دوره بدأ بالخفوت بعد تبنّي ترامب سياسات خارجية جمهورية تقليدية، وفشل إدارته في فرض أجندة بانون والمقربين منه والتي تتعلق بالتجارة العالمية وتغيير قانون التأمين الصحي، ومنع دخول مواطني دول إسلامية إلى الأراضي الأميركية.
وكان بانون قد اتهم كوشنر بأنه “ديمقراطي” بسبب خلافاتهما حول الأجندة الاقتصادية، خصوصاً بعد تعيين كوشنر مقربين منه من مؤسسة “غولدمان ساكس”، وهما غاري كوهن ودينا باول، في مناصب بإدارة ترامب. وشنّ موقع “بريتبارت” المقرب من بانون، هجوماً على كوشنر، واصفاً إياه بـ”الديمقراطي عديم الخبرة”. وبهذا يصبح بانون على عداء معلن مع مستشار الأمن القومي ماكماستر، الذي طلب إقالته من مجلس الأمن القومي. علاوة على كوشنر، زوج إيفانكا ابنة ترامب، في ظل تسريبات حول لعب الأخيرة دوراً كبيراً في التأثير على قرارات والدها السياسية، ولا سيما بعد أن أصبح لها مكتب في البيت الأبيض، باعتبارها “مستشارة” للرئيس، من دون أن يكون لها منصب رسمي بهذا المسمى.
(صحيفة العربي الجديد)
Filed under: كشكول 

March 23, 2017
إجابة “أخلاقية” لسؤال العنف
يبدو أن ميدان دراسات العنف انغلق على نفسه، فمن الصعب الكتابة عن رؤىً جديدة، أو مثيرة للاهتمام (ولا أقول صائبة)، خصوصاً فيما يتعلق بدراسات عنف الحركات التي تعرف على نطاق واسع بالحركات الجهادية. لكن، دائماً هناك مجال لأطروحات جديدة، وأزعم أن جواب طه عبد الرحمن على “سؤال العنف” يأتي برؤية مختلفة، تستحق الاهتمام، والاشتباك معها.
يشتبك طه عبد الرحمن مع مسألة العنف من خلال رؤيته التي ترتكز على الحوار والأخلاق. وذلك في كتابه الذي صدر أخيراً “سؤال العنف … بين الائتمانية والحوارية” عن المؤسسة العربية للفكر والإبداع، والذي يتكون من جزأين، الأول حوار معه حول العنف، والثاني دراسة له عن إيمانويل ليفيناس.
يقرّر عبد الرحمن، ابتداء، أننا نواجه العنف اليوم، بسبب “فقد الحوار وفقد الأخلاق، وعندما يُفقد الحوار وتُفقد الأخلاق في الوقت نفسه، فلا مفر من مواجهة أبشع صور العنف”. ويسلط الضوء على “العنيف”، أو الشخص المرتكب للعنف، في وقتٍ يحلل المشهد الديني الذي يؤدي إلى غرس “القابلية للعنف”، فيرى أن العنيف “متجبر” بالضرورة، وأنه “يأتي من الأفعال ما يوقعه في نسبة الكمالات الإلهية إلى نفسه؛ ذلك أنه يتماهى مع معتقداته الغالية واجتهاداته الشاذّة، فينفذ إلى لاشعوره الاعتقاد بأنه يمثل في الناس إرادة الله”. أما مظاهر هذا “التجبّر”، فيراها في الرغبة بالتسيد على الآخرين، والتكفير، والتقتيل، والتعذيب.
ربما لا توجد لحظة تلخص مظاهر التجبّر التي يتحدّث عنها طه عبد الرحمن، أكثر من فيديوهات الإعدامات التي ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية، وكانت حاضرة من دون شك في ذهن عبد الرحمن، وهو يجيب على “سؤال العنف”، فهي تجمع التسيد والتكفير والتقتيل والتعذيب.
يرى أن “التشدّد الديني” و”الإيذاء المسرف” ناتجان عن أمرين، “فساد فهم النص” و”فساد فهم الواقع”، فيرى أن العنيف “تعامى عن مقاصد الشرع وأسراره”، في وقت استهتر فيه “بسنن التاريخ وقوانين الاجتماع وضرورات الواقع”.
وهنا يُعالج العنف، من خلال نموذج ديني وفقهي مختلف عن النموذج السائد، فإذا كان هذا يقوم على “النموذج الأمري” الذي يؤدي إلى “القابلية للعنف”، من خلال “التذكير بالأوامر وما فيها من المنافع، وبالنواهي وما فيها من المضار” فإن عبد الرحمن يقترح ما يسميه “النموذج الشاهدي”، والذي يذكّر بـ “القيم الأخلاقية التي تتضمنها هذه الأوامر والنواهي”، فيقدم رؤية لعلاج العنف، قائمة على الحوار مع العنيف، وترسيخ قيم أخلاقية، تعالج “قابليته للعنف”.
تنطلق معالجة طه عبد الرحمن للعنف من رؤية مختلفة للإنسان والله والكون، قائمة على “الفلسفة الائتمانية” التي يدور مشروعه الفلسفي حولها بالكامل. لكن شمولية مشروع طه لا تنفي إمكانية الاستفادة جزئياً منها، خصوصاً في معالجته سؤال العنف، ورؤيته للفقه الديني، فحديث عبد الرحمن عن النموذج الفقهي السائد “الأمري” الذي حوّل الدين إلى مجموعة أوامر ونواهٍ، وتجاهل القيم الأخلاقية التي تقف خلفها، يقول الكثير عن المأزق الأخلاقي الذي نعيشه اليوم، وامتد من نفي الأخلاق عن السياسة والاقتصاد، ليصل، في نهاية المطاف، إلى نفيها عن “الفقه الديني”، والمفترض أن يكون آخر حصون “الأخلاق”، إلا أنه لم يكن كذلك، بحسب عبد الرحمن. وهنا، نعود مرة أخرى إلى الرؤى التي تطرح مشروعاً دينياً وفكرياً أوسع لمعالجة العنف، تتجاوز السياسة والاقتصاد والمشكلات الاجتماعية.
.
.
(صحيفة العربي الجديد)
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/3/22/%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D9%D8%A7%D9%D9%8A%D8%A9-%D9%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9-%D8%A7%D9%D8%B9%D9%D9-1
Filed under: مقالات, عروض كتب
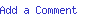

March 9, 2017
الإسلاميون و”قيم المجتمع”
يستبطن السؤال الأول تراجعا وانحدارا، ويطمح للوصول إلى الحد الأدنى، الحفاظ على قيم المجتمع. بينما ينظر سؤال النهضة إلى المستقبل، وإن أقر بالتأخر، فهو يدعو إلى النهضة والتغيير.
أجاب الإسلاميون تاريخيا على سؤال “قيم المجتمع” بطرق مختلفة، فهناك من اعتبر الجواب في التربية، أو الوصول إلى الحكم والهيمنة على الدولة، وهناك من جعله في العودة إلى الجذور والإصلاح العقدي.
سار الإسلاميون في طرق مختلفة، أدّت إلى نهاياتٍ متباينة، فمنهم من انتهى به المطاف محبطا من تغير اجتماعي كبير، لم يستطع صدّه (الإسلاميون في السعودية، إخوان وسرورية). آخرون تحولت أفكارهم نفسها، ورؤيتهم للمجتمع والقيم الإسلامية وعلاقتها بالغرب (راشد الغنوشي وحركة النهضة التونسية نموذجا)، آخرون ما زالوا في فترة تغييراتٍ كبرى (مُفترضة) بعد الكوارث التي حلت بهم (الإخوان المسلمون خصوصا في مصر)، بينما فقد إسلاميون الأمل في الدولة والمجتمع، فتحول إلى العنف ومواجهة الكل (التنظيمات الجهادية).
يعود الداعية السلفي السعودي، محمد السعيدي، إلى موضوع تغير القيم بصورة مفصلة، إلى حد ما، في كتيبٍ عنوانه “الممانعة المجتمعية”، يحاول أن يشخص مشكلات تغير القيم في المجتمعات المسلمة، وأن يضع الحلول لها مختصرة.
ومع أن مصطلح “الممانعة المجتمعية” يبدو جذّابا، إلا أن السعيدي لم يأت بجديد في النقاش القديم الذي يعصف الدوائر الإسلامية منذ عقود، عن التغيرات الاجتماعية والتأثر بالقيم الغربية ومواجهة الغزو الثقافي…إلخ. وعدم وجود جديد ليس اعتراضا بحد ذاته، وإنما الإشكال أن هذه المعالجة القديمة لم تنجح في أوقاتٍ سابقة، فلماذا يتوقع السعيدي أن تنجح اليوم؟
لا يطرح السعيدي مفهوم “الممانعة المجتمعية” بديلا عن ترسيخ الدولة للقيم، لكن ما يمكن استبطانه من طرح السعيدي، والذي يركّز على المجتمع حافظاً للقيم، أنه يرى أن الدول التي قامت في المجتمعات الإسلامية لم تقم بواجبها في حماية القيم، فأصبح التعويل على المجتمع بديلا عن تقاعس هذه الدول.
يحسب للسعيدي شجاعته (وإن كان مخطئا) في تقرير أن المجتمعات الإسلامية فقدت قيمها منذ ألف ومائتي عام، واعتبار الانحراف بدأ منذ الدولة الأموية، وهذه رؤيةٌ “شجاعةٌ” لأنها منسجمة مع الرؤية السلفية. لكن لا يصرح السلفيون بها عادة، باعتبار القرون الأولى كلها مثالية. ومكمن الخطأ هنا في رؤية المجتمع كتلة واحدة، ينفي التعدّد داخله.
مواجهة تغيرات قيم المجتمع، في نظر السعيدي، تكون بالرؤية السلفية التقليدية القائمة على مفاهيم الإصلاح العقدي، والولاء والبراء، ورفض “التشبه بالكفار”، والتأكيد على “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وترسيخ فكرة “خيرية الأمة الإسلامية”…إلخ. هذه الأفكار التي يعيد الإسلاميون طرحها منذ عقود، من دون أن تغير المجتمع فعلا.
بل أصبحت الأوضاع اليوم، خصوصا في السعودية، أكثر تعقيدا، مع رؤية الأفراد المنتمين للحركات الإسلامية، والتي يًفترض أنها غرست في داخلهم كل هذه القيم والمفاهيم، أكثر المتأثرين بالتغيرات الاجتماعية التي يرفضها السعيدي الذي يؤكد، في كتابه، أن ما طرحه حول “الممانعة المجتمعية” نواة لنقاش أوسع، يساهم فيه العلماء والدعاة وغيرهم. وهذه دعوةٌ ممتازة، لكن النقاش يجب أن يبدأ بفحص مسلّمات السعيدي، والتشابك معها، لاختبار ما إذا كان “إعلاء شأن العلماء وحصر الإفتاء فيهم”، على سبيل المثال، أمرا ممكنا اليوم، أو العمل بـ “سد باب الذرائع” فقهيا، خيارا موفقا لمواجهة الجديد.
(العربي الجديد)
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/3/8/%D8%A7%D9%D8%A5%D8%B3%D9%D8%A7%D9%D9%8A%D9%D9-%D9-%D9%D9%8A%D9-%D8%A7%D9%D9%D8%AC%D8%AA%D9%D8%B9-1
Filed under: مقالات


“الأخ الأكبر في جيبك”… دليل أولي لفضح التجسس الأميركي
ما زال “الأخ الأكبر” يراقبك، في كل مكان حرفياً هذه المرة، لا مجرد مبالغات تتعلق بالاتحاد السوفييتي ورفض الدولة الشمولية الشيوعية. المفارقة التي تكشف عنها تسريبات “ويكيليكس” الأخيرة، أن أدوات المراقبة الإلكترونية الحديثة، ذهبت بعيداً في تطورها، في الولايات المتحدة الأميركية، أي في فضاء الديمقراطية الليبرالية الغربية، وفي سياق لا يكشف على وجه الدقة، إن كان موجهاً للخارج فقط، أو تعرض للداخل الأميركي، ما يعني تعقيدات قانونية هائلة تتعلق بخصوصيات وحريات المواطنين الأميركيين. تأتي تسريبات “ويكيليكس”، والتي أطلقها الموقع الثلاثاء تحت عنوان (Vault 7) وشملت آلاف الوثائق المتعلقة بالاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) في سياق التسريبات التقنية البحتة، وإن كانت السياسة حاضرة في صلب عمليتي التجسس والتسريب، بالإضافة إلى عواصف سياسية متوقع أن تثيرها الوثائق، خصوصاً في ما يتعلق بالحرب “السايبرية” التي تُخاض بالخفاء، من دون أن يعلَن عن خسائرها يومياً عبر الإعلام.
تكشف الصفحات والوثائق المسربة، والتي يبلغ عدد دفعتها الأولى 8761 صفحة، عن تفاصيل تقنية تتعلق بآليات التجسس والمراقبة الإلكترونية، وتطوير برمجيات قادرة على اختراق كل شيء، من الهواتف الذكية والكومبيوترات، إلى التلفزيونات الذكية، وأجهزة التحكم عن بُعد، وكل التطبيقات التي يُحكى غالباً عن حصانتها وقدرتها العالية على التشفير.
لكن التسريبات الأخيرة تشير إلى ما هو أخطر، ويتعلق بتورط الحكومة الأميركية، وبشكل متعمد، في تسهيل اختراق الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية. إذ تُظهر الوثائق المسربة أنالحكومة الأميركية متواطئة (من خلال الاستخبارات المركزية) في تسهيل اختراق الأجهزة الإلكترونية، من خلال علمها بوجود ثغرات يمكن استغلالها من القراصنة، ولكنها عوضاً عن التواصل مع الشركات التقنية من أجل إصلاح تلك الثغرات، لمنع اختراق خصوصيات المواطنين الأميركيين، كانت تقوم باستغلالها بصورة مباشرة في الحصول على المعلومات. أي بكلمات أخرى، كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تعرف الثغرات التي يستخدمها القراصنة للتجسس على الأميركيين، وكانت تسمح بهذا، بل تقوم باستغلالها لصالحها.
لكن الوثائق لا تبيّن بصورة دقيقة وقطعية، نطاق استخدام هذه البرمجيات، إذ لا تنص على نطاق عمليات الوكالة، إن كان خارجياً فقط، أو قامت باستخدام هذه التقنيات للتجسس على مواطنين أميركيين. لكن في ظل التنافس بين أجهزة الاستخبارات الأميركية، خصوصاً بين وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الأمن القومي (NSA) فمن غير المستبعد أن تكون هذه البرمجيات قد استُخدمت على نطاق واسع للتجسس على الأميركيين.
وهنا يبدو أن فصل ما هو أميركي عن غير الأميركي في سياق التجسس الإلكتروني أمر غير وارد، فـ”ساحات المعركة” متداخلة في الفضاء الإلكتروني، ومن المستبعد أن يكون القرصان التابع لوكالة الاستخبارات، حريصاً على التمييز حول جنسية الهدف، أو موقعه، خصوصاً أن المساحة ما زالت ضبابية بين المرخّص به، وغير المرخّص، في حروب السايبر.
تكشف الصفحات المسربة عن كمّ كبير من البرمجيات، التي يمكن استخدامها من أي أحد، للقرصنة. وتتضمن برمجيات لاختراق التلفزيونات الذكية، واختراق الكومبيوترات من خلال برمجيات مكافحة الفيروسات التجارية المجانية المتناثرة في الإنترنت.
وتؤكد تسريبات “ويكيليكس” أن هذه الوثائق التي تحوي شفرات وطرقاً تجسسية، كانت متداولة على نطاق واسع، بين موظفي الاستخبارات المركزية ومتعاقدين مع الوكالة الفدرالية، إضافة إلى آلاف القراصنة المتعاونين معها. إذ لم تُصنف هذه الوثائق باعتبارها عالية السرية، ربما لتجنب تصنيفها داخل الوكالة، وبسبب تداولها على نطاق كبير. ويشير الموقع إلى أن الوثائق تم الحصول عليها عبر أحد المتعاونين مع الوكالة الأميركية، إلا أن هناك شكوكاً تدور حول هذا الأمر، ويرجح البعض أن يكون مصدر الوثائق عملية اختراق إلكترونية، روسية أو صينية.
المجموعة الأولى من صفحات وكالة الاستخبارات المركزية المسربة، نشرها موقع “ويكيليكس” تحت عنوان “العام صفر” والتي تشمل وثائق مسربة من مركز “الاستخبارات السايبرية” في لانغلي في ولاية فرجينيا الأميركية. وتتضمن تفاصيل ترسانة البرمجيات التي تستخدمها الوكالة الأميركية لفكر شفرات مؤسسات تقنية كبرى، تشمل برمجيات آبل، وأندرويد، وويندوز.
يعمل تحت مركز الاستخبارات السايبرية، بحسب الصفحات المسربة، أكثر من خمسة آلاف حساب، قاموا بإنتاج آلاف أنظمة التجسس والبرمجيات الخبيثة، والتي استخدمت أسلحة للتجسس وجمع المعلومات وتدمير بيانات. وخطورة هذه البرمجيات، أنه في حالة فقدان السيطرة عليها في فضاء الإنترنت، فيمكن لأي مستخدم لا علاقة له بالوكالة، أن يعيد استخدمها وينجح في القرصنة من خلالها.
وبحسب أحد خبراء التقنية الذين تواصلت معهم “العربي الجديد”، فإن هناك “سوقاً غير أخلاقي” للمعلومات المتعلقة بـ”برمجيات الاختراق والثغرات في الأنظمة الإلكترونية” وأن هذه السوق توصف من باب المبالغة أحياناً، بأنها توازي “سوق الأسلحة”. إذ تحرص الشركات والمؤسسات الاستخباراتية والقراصنة على تداول معلومات الثغرات، والتي في حال انتشارها “يحاول أصحاب البرنامج أو الشركة المطلقة للتطبيق إصلاح الثغرات، كما يحاول القراصنة استغلالها”. ويضيف “بحسب الموارد المتاحة للاستخبارات الأميركية، فمن الطبيعي أن تكون إمكانياتها لكشف الثغرات كبيرة”.
تكشف صفحات “ويكيليكس” المسربة بشكل تفصيلي عن طرق اختراق وتجسس متطورة بصورة غير مسبوقة. مثل تقنية “الملاك الباكي” أو (Weeping Angel) والتي تتعلق باختراق أجهزة التلفزيون الذكية. وتقوم هذه التقنية باستخدام التلفزيون باعتباره جهاز تسجيل (مايكروفون) يقوم بتسجيل المحادثات الدائرة في محيطه، ويرسلها لسيرفرات خاصة بوكالة الاستخبارات الأميركية. وهذه التقنية، بحسب “ويكيليكس”، تعمل حتى في حالة إغلاق التلفزيون، أو ما يعتبر “إغلاقاً مزيفاً”.
وتتحدث وثائق “ويكيليكس” المسربة عن محاولات لاختراق أنظمة تشغيل السيارات الحديثة، للتحكم بها، كما تشير إلى اختراق الهواتف وإرسال كل المعلومات التي يحتويها إلى “سي آي إيه” إضافة إلى إمكانية استخدام كاميرا الهاتف والميكروفون الذي يحتويه لجمع معلومات. وفي هذا السياق، أتاحت إمكانية اختراق الهواتف بصورة مباشرة، تجاوز أنظمة التشفير المستخدمة من تطبيقات المحادثات الإلكترونية، مثل تليغرام وواتساب وسيغنال وغيرها، إذ لم تعد “سي آي إيه” بحاجة لفك تشفير البيانات، ما دامت قادرة على الوصول إليها على الجهاز بصورة مباشرة، قبل التشفير.
وتظهر صفحات “ويكيليكس” استخدام “سي آي إيه” لغة عسكرية بحتة في وصف برمجياتها وعملياتها، فالوكالة تتعامل مع “الحرب السايبرية” باعتبارها فعلاً موازياً للحرب. وربما بهدف إعطاء الوكالة هامشاً أكبر، في “الحرب السايبرية” باعتبارها في “حالة حرب” بصورة أو أخرى.
صفحات “سي آي إيه” المسربة، ستُدخل الوكالة، والحكومة الأميركية، في دوامة أسئلة لا تنتهي على الأرجح، ابتداء بسؤال الخصوصية والحريات الفردية، وليس انتهاء بالأسئلة الاقتصادية المتعلقة بحماية المنتجات الأميركية التقنية، وقدرة الشركات الأميركية على التنافس، وسبل حمايتها، كجزء من حماية الأمن القومي الأميركي، الأمر الذي لا يبدو أنه يجري على ما يرام بحسب وثائق “ويكيليكس” المسربة. فإثبات تسبّب وكالة الاستخبارات الأميركية بأضرار لشركات التقنية الأميركية، من خلال استهداف الأجهزة والبرمجيات التي تُنتجها، وما يترتب على هذا من نقاش اقتصادي وقانوني، قد يتفاعل بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما تجر هذه التسريبات فضائح أكبر، قد تسبب أضراراً بالغة بالترسانة الأميركية في “حرب السايبر” التي يبدو أن الروس باتوا اليوم أكثر تقدماً فيها، من خلال ما يثار عن تدخلهم في الانتخابات الأميركية الأخيرة، أو ما يشاع عن علاقات جوليان أسانج نفسه، وموقع “ويكيليكس”، بالاستخبارات الروسية.
(صحيفة العربي الجديد)
Filed under: من أميركا


March 2, 2017
“داعش إلى أين؟”: محاولة للتأريخ تتجاوز المغالطات السائدة
يعيد فوّاز جرجس في كتابه “داعش إلى أين؟ .. جهاديو ما بعد القاعدة” الاعتبار إلى السياق المحلي العراقي، وسياقات الثورة السورية، والصراعات الإقليمية، لدراسة نشأة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، في الوقت الذي حاول فيه الكثير من المحللين قراءة صعود التنظيم باعتباره نتيجة لتحولات عالمية أوسع مرتبطة بمشكلات الرأسمالية والليبرالية، أو من خلال قراءات لا تاريخية، جوهرانية للمنطقة العربية.
عند الحديث عن ظهور تنظيم الدولة، نجد عددا كبيراً من النظريات التي تحاول تفسير ما تراه غرائبياً ولامفسراً. من اعتبار التنظيم نتيجة لقراءات كتب ابن تيمية، إلى اعتباره مؤامرة على العرب، يقوم بها الصهاينة، أو الأميركيون، أو الإيرانيون… إلخ، وحتى تفسير ظهور التنظيم باعتباره “واجهة” دينية لضباط ورجال دولة عراقيين بعثيين تم تهميشهم بقوانين “اجتثاث البعث” فحاولوا استعادة أمجادهم من بوابة دينية هذه المرة.
يرفض جرجس هذه المغالطات، والتفسيرات “الشعبية” التي أصبح صداها يتردد في الإعلام العربي والغربي على السواء، ويقوم بتبنيها من يطلقون على أنفسهم ألقاب “خبراء في التنظيمات الإرهابية” دون أن يملكوا رؤية دقيقة لما يحدث في المنطقة. لذا يعيد جرجس الاعتبار إلى سياقات عراق ما بعد الاحتلال الأميركي في 2003، وما يدور في سورية، لقراءة صعود داعش كامتداد لظهور أبو مصعب الزرقاوي، وعلاقته المعقدة مع القاعدة.
الزرقاوي والقاعدة
يرى جرجس اختلافاً أساسياً بين استراتيجيات تنظيم القاعدة، وزعيمه الراحل أسامة بن لادن، وبين استراتيجيات القاعدة في بلاد الرافدين الذي أسسها أبو مصعب الزرقاوي، وفق فكرة أولوية “العدو البعيد أو العدو القريب”. فيرى أنه في الوقت الذي رسخ فيه بن لادن فكرة استهداف “العدو البعيد” أي الولايات المتحدة الأميركية، والتي يراها الداعم الأساسي للأنظمة العربية والإسلامية التي يقف ضدها، ويريد إسقاطها. تبنى الزرقاوي رؤية مغايرة، تستهدف “العدو القريب” والذي تحول من كونه المحتل الأميركي، أو الحكومة العراقية الموالية له، ليصبح كل “الشيعة” في حرب طائفية كان الزرقاوي أحد أركانها.
بهذا التفريق، نجد أن تنظيم داعش امتداد لسياسات الزرقاوي، وتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، لا “القاعدة المركزية”. يكتب جرجس: “أحد الوجوه المميزة لاستراتيجية داعش على نقيض القاعدة المركزية هو أنه، وكامتداد لسلفه القاعدة في العراق، ذهب بعيدا في التركيز على الشيعة و العدو القريب، أي النظامين العراقي والسوري وحليفهما الإيراني”.
يضيف جرجس فكرة أخرى لداعش، تميزت بها عن القاعدة، وتتوافق بها مع رؤية الزرقاوي وهي “فكرة القتل الجماعي أو الإبادة”. لكن رغم تشديد جرجس على الاختلافات بين القاعدة وداعش، إلا أنه يراها تشترك في حلم “إقامة الخلافة”.
السياق المحلي العراقي
يرى جرجس أنه “ومع أن داعش هو امتداد للحركة الجهادية الدولية من حيث أيديولوجيته وأفكاره، إلا أن أصوله الاجتماعية متجذرة في سياق عراقي معيّن، وإلى درجة أقل في الحرب السورية التي اندلعت سنة 2011”.
يرى جرجس أن جذور نشأة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” موجودة في سياق تنظيم الزرقاوي “قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين” والذي أعلن الولاء لتنظيم القاعدة، وبايع زعيمه أسامة بن لادن، لأسباب تكتيكية. يكتب جرجس “تظهر قصة زواج المصلحة بين بن لادن والزرقاوي بوضوح أن الجهاديين، وكلاعبين سياسيين، تقودهم المصالح أكثر مما تفعل الأيديولوجيا والدين”.
هذا التنظيم ولد من عدة تداعيات، تمثلت في الاحتلال الأميركي للعراق، وفشل بناء نظام سياسي عراقي متجاوز للطوائف وقادر على حكم جميع العراقيين، إضافة إلى ما يصفه جرجس بـ “الحرب الأهلية السورية” وتداعيات “الربيع العربي”. والتي يراها نتاج فشل الدولة العربية الحديثة، سياسياً وتنموياً، ما أدى إلى انهيارها سريعا في سياق هذه التداعيات.
يتطرق الكاتب بصورة تفصيلية إلى ما يصفه بـ “إخفاق المؤسسات السياسية” العراقي في إدماج السنة بالدولة العراقية، تارة تحت لافتة “اجتثاث البعث” وأخرى بسبب اتهامات بالإرهاب، أو بسبب السياسات الطائفية التي انتهجها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وخشيته من إتاحة مجال لمشاركة السنة في حكم العراق.
هذا السياق العراقي، لم يؤثر فقط في ظهور التنظيم، وصعوده لاحقاً، لكن في أهم خصائصه، وهو ما يصفه الكاتب بـ “العنف الزائد” والذي يفسره باعتباره نتيجة لثلاثة عوامل، هي “انتسابه الأصلي إلى القاعدة في العراق، وموجدها أبو مصعب الزرقاوي… الذي ركز على مسألتي الهوية والسياسة المحلية” إضافة إلى “عراقيته (التنظيم) الغالبة واستعارته الأدوات البعثية في القمع إضافة إلى إرث البلاد المرّ من العنف” وأخيراً “ريفيه ضباط التنظيم وأفراده”.
وهنا يقرأ جرجس العنف باعتباره امتدادا لسياق العنف في العراق بعد 2003، وامتدادا للاستبداد وقمعية دولة حزب البعث التي حكمت العراق من 1968 حتى الاحتلال الأميركي. وهنا يمكن إضافة أن هذا العنف مرتبط بالدولة الحديثة، لا التراث. على غرار أوصاف عالم الاجتماع الأميركي تشارلز تيلي، والتي تعتبر إنشاء الدول الحديثة “جريمة منظمة” قام بها سياسيون يحاكون أعمال العصابات.
مستقبل التنظيم
يختم جرجس كتابه بقراءة لـ “مستقبل داعش” تدمج ما بين رؤيته لمستقبل التنظيم، والمنطقة، على حد سواء. يرى الكاتب أنه إذا كان صعود التنظيم ناتج عن “تحطّم مؤسسات الدولة في قلب الوطن العربي، وصراع الهويات بين المسلمين السنة والشيعة” فإن مواجهة داعش محكومة بـ “قدرة المجتمعات العربية، مع القوى الإقليمية والدولية، على توفيق حل سلمي للنزاعات الأهلية ولدعم إعادة بناء الدول العربية ومؤسساتها وفق قواعد شفافه وشرعية”.
لكن هناك مشكلة أكبر تلوح في الأفق، صحيح أن داعش تنظيم يمكن هزيمته، على خلاف ما يحاول قادة التنظيم الترويج له، إلا أن هزيمة التنظيم، دون معالجة الأسباب البنيوية التي خلقته وساهمت في صعوده أول الأمر، ستعني أن التنظيم سيختفي من الساحة، لكن أفراده سيكونون قادرين على إعادة تجربة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، عندما هزم التنظيم، وذاب أفراده في المنطقة، ثم عادوا بعد سنوات، ليساهموا في صعود جماعة إرهابية أكبر وأخطر، وأكثر قسوة: داعش.
لا يتجاهل جرجس عوامل أخرى، يراها هامة في حسم مستقبل التنظيم، مثل ترسيخ فصل الدين عن الدولة في المنطقة، ومواجهة الرؤية السلفية المتشددة، إضافة إلى إيجاد حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، كمشاكل مؤثرة في ظهور تنظيمات “السلفية الجهادية” في المنطقة، وإن كانت أقل حسما في ظهور هذه التنظيمات، من تلك المتعلقة بانهيار الدولة، والتدخلات الأجنبية، وصراع الهويات.
لكن جرجس يتجاهل في مقاربة موضوع “فصل الدين عن الدولة” أن الأنظمة التي فشلت في بناء الدولة العربية الحديثة، في العراق وسورية، وساهم انهيارها في ظهور التنظيمات السلفية الجهادية، لم تكن أنظمة “دينية” بل “عَلمانية” ولكنها وإن واجهت الأدبيات السلفية ثقافياً، إلا أنها وضعت بذور الخلافات الطائفية التي اشتعلت في المنطقة مؤخراً.
كتاب “داعش إلى أين؟ … جهاديو ما بعد القاعدة” من إصدارات “مركز دراسات الوحدة العربية” وصدرت طبعته الأولى في 2016، وهو من ترجمة محمد شيّا، في الوقت الذي صدرت فيه النسخة الأصلية، الإنكليزية، من الكتاب، في العام ذاته، بعنوان (ISIS: A History).
بدر الراشد / موقع ضفة ثالثة
Filed under: عروض كتب


بدر الراشد's Blog
- بدر الراشد's profile
- 10 followers



