الولي الفقير (1): مسعود بن حدّو أكروح. الأرض والأصل. تأليف: إلياس بلكا.
الولي الفقير (1): مسعود بن حدّو أكروح.
الأرض والأصل.
تأليف: إلياس بلكا.
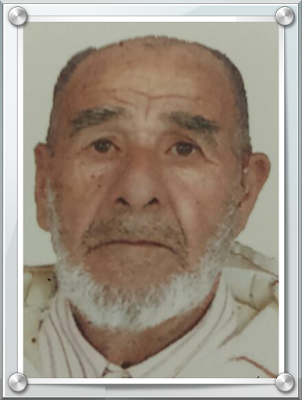
(لا توجد صورة للحاج مسعود، وهذه صورة ابنه المرحوم الحاج حدّو الذي يشبهه كثيرا.)
نتعرّف اليوم على شخصية صالحة، من طراز مختلف عمّا سبق في هذه السلسلة. فهو شخص توفي إلى رحمة الله منذ خمسة وسبعين سنة، لم يكن شيخا ولا عالما ولا أميرا.. لكنه كان من أولياء الله الصادقين المتقين، يصدق عليه حديث الحاكم وابن ماجه وغيرهما، وصححه الذهبي وغيره عن معاذ: سمعتُ رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: " إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء.. قلوبهم مصابيح الهدى.. يخرجون من كل غبراء مظلمة." أي أن الله يحفظهم من كل فتنة مُضلة. وفي معناه حديث مسلم: "إن الله يحب العبد التقيّ الغني الخفي".إنه الحاج مسعود بن حدو بن شعيب بن أكروح.ولد رحمه الله سنة 1878 بمدشر اغميرن، ببني بوعياش، أحد الأقسام الستة للقبيلة الصنهاجية الكبيرة بني ورياغل. وسنقدّم لهذا المقال ببعض المعلومات الأساسية: الريف: تتنوّع مدلولات مصطلح الريف: فجغرافيا يـُقصد به السلسلة الجبلية من طنجة إلى مصب ملوية. وسُكانيا يعتبر الريف خليطا من الأمازيغ (من قبائل متنوعة وهي أساسا: صنهاجة ومصمودة وزناتة) ومن العرب والأندلسيين.. وإداريا كان للريف حدود متحركة بحسب الزمان، فقد يمتدّ من نهر ملوية إلى طنجة أو إلى واد أورينكا أو أرنيغة بشفشاون، وقد ينكمش حتى إلى المساحة ما بين بادس وواد النكور. كان الريف من أُولى المناطق التي دخلها الفاتحون العرب بهذا القُطر المغربي، وشكّل على مرّ التاريخ أحد أهم أقاليم مملكة فاس. لذلك كانت "النكور" أول مدينة إسلامية بالمغرب، في حين اعتُبرت بادس المدينة الثانية. دوار اغميرن: وقد ولد الحاج مسعود رحمه الله ونشأ بهذا الدوار الذي ينتمي إلى "اغمارة"، وهو تعريب للمصطلح الأمازيغي "اغميرن"، أو يمكن أن يكون معناه سكان غمارة، فتكون غمارة عبارة عن الأرض، واغميرن هم الناس الذين يعمّرونها، ومفردها "أغمير" أي الغماري. وترجع أصول سكان دوار اغميرن من منطقة منابع واد غيس، ثان واد بالحسيمة، أي أنهم نزحوا من منطقة ما تقع في المثلث ما بين جنوب بني حذيفة وسيدي بوتميم (شرق تاركيست) وزاوية سيدي عبد القادر، وهو مثلث جبلي بامتياز. والظاهر أن أكروح الكبير هو الذي هاجر من مكانٍ مّا في هذا المثلث، وأسس دوار اغميرن في نهاية القرن 18 وبداية 19. فما هي غمارة إذن؟ غمارة والأصل الغماري: غمارة هي مجموعة قبائل ريفية مصمودية الأصل، ويرى ابن خلدون أن أهل غمارة من ولد غمار بن آصاد بن مصمود، فالمصامدة هم أهل الجبال بالمغرب الأقصى، وهم قبائل كثيرة، لكن أهم قبائل مصمودة هي اغمارة.ولا يوجد اتفاق على المجال الجغرافي لقبائل غمارة، فغمارة القديمة إقليم واسع من بادس شرقا (وعند بعضهم -كالبكري- من نكور، وعند ابن خلدون من غساسة) إلى طنجة وبلاد الهبط غربا، وجنوبا حتى نواحي وزان وفاس وتازة. ثم أصبح الإقليم عبارة عن الأرض ما بين واد لاو وواد النكور. ولاحقا اصطُلِح على تسمية المناطق الغربية لغمارة بـ: جبالة، وهي الآن سبع قبائل. بينما بقي القسم الشرقي محتفظا باسم غمارة. وهذه المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي، إذ هي الممرّ إلى الأندلس، ولها واجهة بحرية هي الأقرب إلى أوربا.. لكن هذا أيضا جعلها في قلب الصراعات السياسية والعسكرية بين الدول والشعوب الكبرى، فعانتْ من ذلك.وقد عُرف عن القبائل الغمارية شدة تمسكها بالإسلام، واحتضنت على مرّ التاريخ عددا كبيرا من المساجد والمدارس والمعاهد والزوايا والأربطة، فراجت فيها الحركة العلمية ونبغ فيها عدد من العلماء في تخصصات مختلفة، كما عاش في رحابها كثير من الصلحاء والأولياء، يكفي أن نذكر منهم: عبد السلام بن مشيش وأبي الحسن الشاذلي ومحمد البوزيدي وعلي حسون وصلحاء بادس... وغيرهم كثير.وتعتبر منطقة غمارة مصدرَ هجرة مستمرة وتاريخية إلى ما يشكل حاليا منطقة الحسيمة التي تُقدّر نسبة سكانها -فقط من ذوي الأصول الجبالية- بالخُمس، أي من غرب غمارة.. فإذا أضفنا ذوي الأصول من شرق غمارة أصبحت النسبة كبيرة جدا. الهجرة الأندلسية إلى الريف: وقد خطر لي احتمال أن تكون أصول آل أكروح أندلسية، وذلك لمجموعة قرائن: منها وجود نسبة مهمة من الشُّقر ذوي العيون الزرقاء والبشرة المفتوحة في آل أكروح. ومنها استيطانهم قريبا من البحر، وكذلك كان الأندلسيون يفعلون، أملاً منهم في العودة لبلادهم التي طُردوا منها، وللاشتغال بالجهاد البحري ضد الإسبان والبرتغال. ومنها وجودهم بقرى صغيرة، وكذلك الأندلسيون كانوا يفضلون السكن في المغرب بالحواضر الصغرى، وأحيانا بالقرى المهجورة، ليبنوا مجتمعا خاصا بهم. ومنها انخراطهم بقوة في جهاد محمد بن عبد الكريم الخطابي ضد الاستعمار الإسباني.ومنها الاسم: أكروح، وإن كان بحثنا في المعاجم الإسبانية والبرتغالية لم يعط أيّ نتيجة.. كما في المعاجم الأمازيغية أيضا. ولا أستبعد أن يكون الاسم مركّبا من كلمتين، إما من لغة واحدة، أو من لغتين.لكن لم أجد دليلا معتبرا على هذه النظرية، ويظل هذا الاحتمال الأندلسي قائما، خاصة إذا علمنا أن المؤرخين يقدّرون أن 10% على الأقل من سكان المغرب هم من أصول أندلسية، وأن معظمهم نسي هذا الأصل. وهذه النسبة تتضاعف بالريف. وذلك لأن موطن غمارة هو المدخل الأول إلى الأندلس، فهاجرت أسر أندلسية كثيرة إلى المنطقة، كما في سنة 1483م قبل سقوط مدينة غرناطة. ثم بدأت هجرة أخرى بعد سقوط مملكة بني الأحمر سنة 897 ﻫ موافق 1492م. ثم ازدادت وتيرة الهجرة بعد قرار الملكة إيزابيلا طرد مسلمي الأندلس عام 1502. وكذا بعد فشل ثورة بقايا المسلمين بغرناطة سنة 1571 ضد مملكة قشتالة. وأخيرا عرف الريف الأوسط الهجرة الأندلسية النهائية في سنتيْ 1609-1610م، في عهد الملك فيليبي الثالث الذي طرد آخر مسلمي إسبانيا.وقد استفاد الريف من هذه الهجرات، التي قصدتْ في البداية الريفيْن الأوسط والغربي، فتطورّت مدن: المزمة (قريبا من مصبّ نكور)، وبادس، وغساسة (مدينة قريبة من مليلية).. واستقبلت منطقةُ غمارة أهلَ غرناطة ولوشة وقرية الفخار ومرشانة.. بينما استقبلت بادس –وهي المدينة التي تشبه مدن الأندلس وكانت قريبة منها وتميّزت بالصلاح- أهلَ مالقة بالخصوص.. لذلك توجد كثير من الأسر الأندلسية -خاصة المالقية- بمناطق بني ورياغل وغمارة. الفرس بالمغرب والأندلس: إذا كان موطن آل أكروح الحديث هو دوّار اغميرن، فإنهم ما لبثوا في بدايات القرن العشرين أن نزل بعضهم إلى مدشر قريب يسمى: آيت فارس. وهنا مرّة أخرى لابد أن نتوقف عند الاسم قليلا، وهذا منهج تأريخي معروف يسمى: La Toponymieنلاحظ انتشارا لكلمة فارس وفارسي وأبو فارس بالغرب الإسلامي، ففي موسوعة "معلمة المغرب ج19" عددٌ من أعلامهم، كابن فارس: أسرةٌ تطوانية، أندلسية الأصل.وحاليا أولاد فارس قرية كبيرة في سطات. كذلك اسم الفارسي من الأسماء العائلية في المغرب، وهو في الغالب نسبةً لبلاد فارس، كالصقلي والعراقي والشامي.. ذلك أن للفرس وجودا بالمنطقة منذ القديم، فقد كان في جيش طارق جماعات من الفرس، ومع ظهور الدولة العباسية جاء آخرون واستوطنوا الغرب الإسلامي. كما وفدتْ من الشرق أسر فارسية كثيرة على إدريس الأزهر في الفترة التي بنى فيها مدينة فاس، وفرح بهم، وأنزلهم بعين علون (تسمى اليوم: عين علو).وفي الفترة نفسها تقريبا تأسست بتاهرت (وتسمى الآن: تيارت، شرق وهران) الإمارةُ الرستمية التي كانتْ تتبع المذهب الإباضي، وذلك على يد عبد الرحمن بن رستم، وهو فارسي، وكان حاكما عادلا صالحا، وجدٌّه مولى لسيدنا عثمان بن عفان. لكن عبد الرحمن نشأ بالقيروان وتفقـّه بها. فازدهرت الدولة في عهده، ثم أوْدَت بها خلافات العائلة الحاكمة التي استغلها العبيديون أو الفاطميون الذين جاؤوا من تونس فأنهوْا الإمارة الرستمية.وتوجد قرائن على أن هجرة الفرس والخراسانيين استمرتْ وتواصلت، وإن ببطء، فاستوطن بعضهم الزاب بجنوب الجزائر، وآخرون نواحي فاس، وآخرون نزلوا بسجلماسة جهة مراكش، ثم انتهت الهجرة باستقرار آخرِ مجموعةٍ بسوس. وبعد قرون من هذا، سجّل ابن بطوطة في رحلته وجودَ جماعة فارسية مهمة بغرناطة. لا عجب إذن أن نجد كلمات فارسية في اللهجة الجبلية.وكل هؤلاء الفرس كانوا أهل سنّة، لأن تشيّع بلاد فارس كان متأخرا، إذ حدث منذ أربعة قرون فقط. كما أن حجم هذه الهجرات لم يكن كبيرا، فهي في الواقع محدودة، لكنها موجودة. فالظاهر إذن أن جماعة فارسية الأصل كانت قد استوطنتْ هذه القرية، كما يحتمل أن جزءً من سكانها الأصليين هؤلاء بقوا فيها إلى اليوم. آيت فارس: بني بوعياش القديمة. يمكن اعتبار هذه القرية ومحيطها بمثابة النواة الحضرية الأهم للمنطقة التي تسمى حاليا: بني بوعياش والتي تضم 17 مدشرا. فهي تتوسط هذه القرى. كما أنها الأقرب لحوض النكور، وهو المصدر الرئيس للفلاحة بهذه الجهة. وبجانبها أيضا نهر صغير يصب في الحوض المذكور.وقد كانت آيت فارس –إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي- عاصمة دينية وعلمية لهذه الجهة، وذلك لوجود مسجد جامع هو الأقدم في المنطقة، مع مدرسة لتحفيظ القرآن وتدريس المعارف الأولية: الدينية واللغوية، وكانت تستقبل تلامذة من خارج القرية. كما ضمّت أيضا الزاويةَ الرئيسة بالجهة، وهي المؤسسة التي كانت تقوم بأدوار مختلفة في حياة الجماعة، كما هو مشهور من تاريخ المغرب.. أدوارٌ تتجاوز الرسالة الدينية إلى تنظيم عام للشؤون الاجتماعية والاقتصادية للجماعة.ربما هذا كله دفع بالسيد مسعود إلى ترك دوار اغميرن والاستقرار بأيت فارس.أما مدينة بني بوعياش الحالية فكانت مجرد طريق يربط بين الحسيمة والناظور قبل أن تبدأ نواة المدينة في التشكّل في الخمسينيات والستينيات.. وكان لأسرة أكروح الكريمة مساهمة عظيمة في تأسيس المدينة التي يقع مركزها في أراضيهم الخاصة. يتبع..
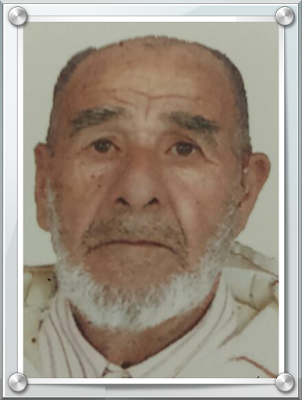
(لا توجد صورة للحاج مسعود، وهذه صورة ابنه المرحوم الحاج حدّو الذي يشبهه كثيرا.)
نتعرّف اليوم على شخصية صالحة، من طراز مختلف عمّا سبق في هذه السلسلة. فهو شخص توفي إلى رحمة الله منذ خمسة وسبعين سنة، لم يكن شيخا ولا عالما ولا أميرا.. لكنه كان من أولياء الله الصادقين المتقين، يصدق عليه حديث الحاكم وابن ماجه وغيرهما، وصححه الذهبي وغيره عن معاذ: سمعتُ رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: " إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء.. قلوبهم مصابيح الهدى.. يخرجون من كل غبراء مظلمة." أي أن الله يحفظهم من كل فتنة مُضلة. وفي معناه حديث مسلم: "إن الله يحب العبد التقيّ الغني الخفي".إنه الحاج مسعود بن حدو بن شعيب بن أكروح.ولد رحمه الله سنة 1878 بمدشر اغميرن، ببني بوعياش، أحد الأقسام الستة للقبيلة الصنهاجية الكبيرة بني ورياغل. وسنقدّم لهذا المقال ببعض المعلومات الأساسية: الريف: تتنوّع مدلولات مصطلح الريف: فجغرافيا يـُقصد به السلسلة الجبلية من طنجة إلى مصب ملوية. وسُكانيا يعتبر الريف خليطا من الأمازيغ (من قبائل متنوعة وهي أساسا: صنهاجة ومصمودة وزناتة) ومن العرب والأندلسيين.. وإداريا كان للريف حدود متحركة بحسب الزمان، فقد يمتدّ من نهر ملوية إلى طنجة أو إلى واد أورينكا أو أرنيغة بشفشاون، وقد ينكمش حتى إلى المساحة ما بين بادس وواد النكور. كان الريف من أُولى المناطق التي دخلها الفاتحون العرب بهذا القُطر المغربي، وشكّل على مرّ التاريخ أحد أهم أقاليم مملكة فاس. لذلك كانت "النكور" أول مدينة إسلامية بالمغرب، في حين اعتُبرت بادس المدينة الثانية. دوار اغميرن: وقد ولد الحاج مسعود رحمه الله ونشأ بهذا الدوار الذي ينتمي إلى "اغمارة"، وهو تعريب للمصطلح الأمازيغي "اغميرن"، أو يمكن أن يكون معناه سكان غمارة، فتكون غمارة عبارة عن الأرض، واغميرن هم الناس الذين يعمّرونها، ومفردها "أغمير" أي الغماري. وترجع أصول سكان دوار اغميرن من منطقة منابع واد غيس، ثان واد بالحسيمة، أي أنهم نزحوا من منطقة ما تقع في المثلث ما بين جنوب بني حذيفة وسيدي بوتميم (شرق تاركيست) وزاوية سيدي عبد القادر، وهو مثلث جبلي بامتياز. والظاهر أن أكروح الكبير هو الذي هاجر من مكانٍ مّا في هذا المثلث، وأسس دوار اغميرن في نهاية القرن 18 وبداية 19. فما هي غمارة إذن؟ غمارة والأصل الغماري: غمارة هي مجموعة قبائل ريفية مصمودية الأصل، ويرى ابن خلدون أن أهل غمارة من ولد غمار بن آصاد بن مصمود، فالمصامدة هم أهل الجبال بالمغرب الأقصى، وهم قبائل كثيرة، لكن أهم قبائل مصمودة هي اغمارة.ولا يوجد اتفاق على المجال الجغرافي لقبائل غمارة، فغمارة القديمة إقليم واسع من بادس شرقا (وعند بعضهم -كالبكري- من نكور، وعند ابن خلدون من غساسة) إلى طنجة وبلاد الهبط غربا، وجنوبا حتى نواحي وزان وفاس وتازة. ثم أصبح الإقليم عبارة عن الأرض ما بين واد لاو وواد النكور. ولاحقا اصطُلِح على تسمية المناطق الغربية لغمارة بـ: جبالة، وهي الآن سبع قبائل. بينما بقي القسم الشرقي محتفظا باسم غمارة. وهذه المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي، إذ هي الممرّ إلى الأندلس، ولها واجهة بحرية هي الأقرب إلى أوربا.. لكن هذا أيضا جعلها في قلب الصراعات السياسية والعسكرية بين الدول والشعوب الكبرى، فعانتْ من ذلك.وقد عُرف عن القبائل الغمارية شدة تمسكها بالإسلام، واحتضنت على مرّ التاريخ عددا كبيرا من المساجد والمدارس والمعاهد والزوايا والأربطة، فراجت فيها الحركة العلمية ونبغ فيها عدد من العلماء في تخصصات مختلفة، كما عاش في رحابها كثير من الصلحاء والأولياء، يكفي أن نذكر منهم: عبد السلام بن مشيش وأبي الحسن الشاذلي ومحمد البوزيدي وعلي حسون وصلحاء بادس... وغيرهم كثير.وتعتبر منطقة غمارة مصدرَ هجرة مستمرة وتاريخية إلى ما يشكل حاليا منطقة الحسيمة التي تُقدّر نسبة سكانها -فقط من ذوي الأصول الجبالية- بالخُمس، أي من غرب غمارة.. فإذا أضفنا ذوي الأصول من شرق غمارة أصبحت النسبة كبيرة جدا. الهجرة الأندلسية إلى الريف: وقد خطر لي احتمال أن تكون أصول آل أكروح أندلسية، وذلك لمجموعة قرائن: منها وجود نسبة مهمة من الشُّقر ذوي العيون الزرقاء والبشرة المفتوحة في آل أكروح. ومنها استيطانهم قريبا من البحر، وكذلك كان الأندلسيون يفعلون، أملاً منهم في العودة لبلادهم التي طُردوا منها، وللاشتغال بالجهاد البحري ضد الإسبان والبرتغال. ومنها وجودهم بقرى صغيرة، وكذلك الأندلسيون كانوا يفضلون السكن في المغرب بالحواضر الصغرى، وأحيانا بالقرى المهجورة، ليبنوا مجتمعا خاصا بهم. ومنها انخراطهم بقوة في جهاد محمد بن عبد الكريم الخطابي ضد الاستعمار الإسباني.ومنها الاسم: أكروح، وإن كان بحثنا في المعاجم الإسبانية والبرتغالية لم يعط أيّ نتيجة.. كما في المعاجم الأمازيغية أيضا. ولا أستبعد أن يكون الاسم مركّبا من كلمتين، إما من لغة واحدة، أو من لغتين.لكن لم أجد دليلا معتبرا على هذه النظرية، ويظل هذا الاحتمال الأندلسي قائما، خاصة إذا علمنا أن المؤرخين يقدّرون أن 10% على الأقل من سكان المغرب هم من أصول أندلسية، وأن معظمهم نسي هذا الأصل. وهذه النسبة تتضاعف بالريف. وذلك لأن موطن غمارة هو المدخل الأول إلى الأندلس، فهاجرت أسر أندلسية كثيرة إلى المنطقة، كما في سنة 1483م قبل سقوط مدينة غرناطة. ثم بدأت هجرة أخرى بعد سقوط مملكة بني الأحمر سنة 897 ﻫ موافق 1492م. ثم ازدادت وتيرة الهجرة بعد قرار الملكة إيزابيلا طرد مسلمي الأندلس عام 1502. وكذا بعد فشل ثورة بقايا المسلمين بغرناطة سنة 1571 ضد مملكة قشتالة. وأخيرا عرف الريف الأوسط الهجرة الأندلسية النهائية في سنتيْ 1609-1610م، في عهد الملك فيليبي الثالث الذي طرد آخر مسلمي إسبانيا.وقد استفاد الريف من هذه الهجرات، التي قصدتْ في البداية الريفيْن الأوسط والغربي، فتطورّت مدن: المزمة (قريبا من مصبّ نكور)، وبادس، وغساسة (مدينة قريبة من مليلية).. واستقبلت منطقةُ غمارة أهلَ غرناطة ولوشة وقرية الفخار ومرشانة.. بينما استقبلت بادس –وهي المدينة التي تشبه مدن الأندلس وكانت قريبة منها وتميّزت بالصلاح- أهلَ مالقة بالخصوص.. لذلك توجد كثير من الأسر الأندلسية -خاصة المالقية- بمناطق بني ورياغل وغمارة. الفرس بالمغرب والأندلس: إذا كان موطن آل أكروح الحديث هو دوّار اغميرن، فإنهم ما لبثوا في بدايات القرن العشرين أن نزل بعضهم إلى مدشر قريب يسمى: آيت فارس. وهنا مرّة أخرى لابد أن نتوقف عند الاسم قليلا، وهذا منهج تأريخي معروف يسمى: La Toponymieنلاحظ انتشارا لكلمة فارس وفارسي وأبو فارس بالغرب الإسلامي، ففي موسوعة "معلمة المغرب ج19" عددٌ من أعلامهم، كابن فارس: أسرةٌ تطوانية، أندلسية الأصل.وحاليا أولاد فارس قرية كبيرة في سطات. كذلك اسم الفارسي من الأسماء العائلية في المغرب، وهو في الغالب نسبةً لبلاد فارس، كالصقلي والعراقي والشامي.. ذلك أن للفرس وجودا بالمنطقة منذ القديم، فقد كان في جيش طارق جماعات من الفرس، ومع ظهور الدولة العباسية جاء آخرون واستوطنوا الغرب الإسلامي. كما وفدتْ من الشرق أسر فارسية كثيرة على إدريس الأزهر في الفترة التي بنى فيها مدينة فاس، وفرح بهم، وأنزلهم بعين علون (تسمى اليوم: عين علو).وفي الفترة نفسها تقريبا تأسست بتاهرت (وتسمى الآن: تيارت، شرق وهران) الإمارةُ الرستمية التي كانتْ تتبع المذهب الإباضي، وذلك على يد عبد الرحمن بن رستم، وهو فارسي، وكان حاكما عادلا صالحا، وجدٌّه مولى لسيدنا عثمان بن عفان. لكن عبد الرحمن نشأ بالقيروان وتفقـّه بها. فازدهرت الدولة في عهده، ثم أوْدَت بها خلافات العائلة الحاكمة التي استغلها العبيديون أو الفاطميون الذين جاؤوا من تونس فأنهوْا الإمارة الرستمية.وتوجد قرائن على أن هجرة الفرس والخراسانيين استمرتْ وتواصلت، وإن ببطء، فاستوطن بعضهم الزاب بجنوب الجزائر، وآخرون نواحي فاس، وآخرون نزلوا بسجلماسة جهة مراكش، ثم انتهت الهجرة باستقرار آخرِ مجموعةٍ بسوس. وبعد قرون من هذا، سجّل ابن بطوطة في رحلته وجودَ جماعة فارسية مهمة بغرناطة. لا عجب إذن أن نجد كلمات فارسية في اللهجة الجبلية.وكل هؤلاء الفرس كانوا أهل سنّة، لأن تشيّع بلاد فارس كان متأخرا، إذ حدث منذ أربعة قرون فقط. كما أن حجم هذه الهجرات لم يكن كبيرا، فهي في الواقع محدودة، لكنها موجودة. فالظاهر إذن أن جماعة فارسية الأصل كانت قد استوطنتْ هذه القرية، كما يحتمل أن جزءً من سكانها الأصليين هؤلاء بقوا فيها إلى اليوم. آيت فارس: بني بوعياش القديمة. يمكن اعتبار هذه القرية ومحيطها بمثابة النواة الحضرية الأهم للمنطقة التي تسمى حاليا: بني بوعياش والتي تضم 17 مدشرا. فهي تتوسط هذه القرى. كما أنها الأقرب لحوض النكور، وهو المصدر الرئيس للفلاحة بهذه الجهة. وبجانبها أيضا نهر صغير يصب في الحوض المذكور.وقد كانت آيت فارس –إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي- عاصمة دينية وعلمية لهذه الجهة، وذلك لوجود مسجد جامع هو الأقدم في المنطقة، مع مدرسة لتحفيظ القرآن وتدريس المعارف الأولية: الدينية واللغوية، وكانت تستقبل تلامذة من خارج القرية. كما ضمّت أيضا الزاويةَ الرئيسة بالجهة، وهي المؤسسة التي كانت تقوم بأدوار مختلفة في حياة الجماعة، كما هو مشهور من تاريخ المغرب.. أدوارٌ تتجاوز الرسالة الدينية إلى تنظيم عام للشؤون الاجتماعية والاقتصادية للجماعة.ربما هذا كله دفع بالسيد مسعود إلى ترك دوار اغميرن والاستقرار بأيت فارس.أما مدينة بني بوعياش الحالية فكانت مجرد طريق يربط بين الحسيمة والناظور قبل أن تبدأ نواة المدينة في التشكّل في الخمسينيات والستينيات.. وكان لأسرة أكروح الكريمة مساهمة عظيمة في تأسيس المدينة التي يقع مركزها في أراضيهم الخاصة. يتبع..
Published on May 19, 2017 15:56
No comments have been added yet.
إلياس بلكا's Blog
- إلياس بلكا's profile
- 50 followers
إلياس بلكا isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.



